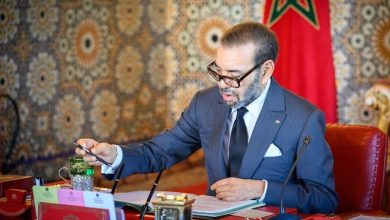صدر للكاتب و الصحفي عبد الحميد جماهري مقال في موقع “العربي الجديد” بعنوان “كيف يبدو سقوط دمشق من شرفة في الرباط؟”. و نظرا لأهمية المقال، نعيد نشره بالكامل.
بقلم: عبد الحميد جماهري

لم تُخفِ قطاعات واسعة من الرأي العام المغربي ترحيبها بسقوط نظام آل الأسد في سورية. ولم تكن مشاهد مواكب السيارات في الدار البيضاء والرباط، لسوريين فوق التراب المغربي، المظاهر الوحيدة للترحيب بنهاية بشّار الأسد، بل تكاثرت في وسائط التواصل الاجتماعي، وفي الكتابات الصحافية، عناوين التفاعل الإيجابي مع نهاية سنة أخرى من المأساة السورية (أو الفصل 41 المسلح منها على أقلّ تقدير). منها ما ترى العكس، وتتعاطف مع النظام، أو تتحفّظ في الترحيب بنهايته وتثقل المرحلة بأسئلة الـ “ما بعد”، لارتباطات قومية بعثية سابقة أو بناءً على التحليل الظرفي القائم على عناصر الصراع الجديدة منذ 7 أكتوبر (3202)، لكنّها أصوات قليلة، ولا تتحدّث عن العلاقة الثنائية مع المغرب حصرياً، غالباً ما تعلّل مواقفها بما حصل من نتائج “الربيع العربي”، والفوضى التي أعقبته، و”خريفها” في ليبيا وتونس واليمن…
ثقّف بعض المثقّفين ثوريتهم بالآداب البعثية السورية، وكان جزء من المنظومة الفكرية الإقليمية يأخذ دمشق قبلةً في تحليل موازين القوى، وغير قليل من الجهاز المفاهيمي تربّى في حضن بعثية السوريين، علاوة على ارتباط دمشق بجزء من الجبهة الفلسطينية الجذرية، قبل أن تتصدّر الثورية الإسلامية المشهد الفلسطيني، بعد تعثّرات السلام في “أوسلو” وتراجع خطابه وتهالك واقعيته.
يسعد الرأي العام المغربي بسقوط نظام وضع دعم “بوليساريو” ثابتاً سياسياً في العلاقة مع شعوب المغرب الكبير
كان المغرب الكبير منطقة ملتهبة من العالم العربي الإسلامي، تشكّل فيها القومية تحدّياً كبيراً، وامتداداً جيوسياسياً لصراعات الشرق الأوسط وثقافته في تدبير ما كانت تعتبره هذه الثقافة “نهضة الأمة”. ومنذ ذلك التاريخ، تساقط كثير من البناء العلائقي للثورة للقومية، الناصرية، والبعثية العراقية، والقومية الماركسية (كما في تجربة اليمن المقسّم) وبقيت آثاره قائمةً في التحليل وتحديد المزاج القومي العام، حنيناً أو معاندةً.
وفي لحظة الواقع الحالي للمغرب في علاقته بسورية، رجعت إلى الذاكرة الجماعية تفاعلات كيمياء الماضي، واسترجعت معها الذات الجمعية للمغاربة مرحلةَ التجريدة المغربية في حرب الجولان، وهي تجربة قادها الملك الراحل الحسن الثاني، ودشّن بها التضامن المغربي مع سورية، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 1973بنصف سنة تقريباً، واختار الذكرى 17 لتأسيس القوات المسلحة الملكية لتنظيم استعراض عسكري للتجريدة التي ستغادر إلى سورية، بعد أن وضع لقيادتها الجنرال عبد السلام الصفريوي. وقد توّجت المشاركة المغربية بأثرين معنويَّين متنافرَين. تمثّل الأول في مرسوم رئاسي يمنح لقب بطل الجمهورية العربية السورية، إلى كلّ من الصفريوي في جبهة الجولان، وشهيد الجولان المغربي الكولونيل عبد القادر العلّام، ليكونا من أول الضباط غير السوريين، الذين منحوا هذا التشريف العسكري. وهو أثر يسترجع البطولة المغربية في جبهة بعيدة جغرافياً، وإن كانت من صميم الانتماء التحرّري والسياسي للمغاربة.
تمثّل الأثر الآخر، في ما روي من بعد عن التخلّي عن التجريدة المغربية، بعد البلاء الأكيد لها في الجولان، وفي مرتفعات جبل الشيخ تحديداً، وتركها عرضة للطيران الإسرائيلي بعد انسحابٍ غير مفهوم للقوات السورية. ولولا التدخّل العراقي لكانت الخسائر البشرية أفدح مما سقط يومها في ساحة الشرف، ودفن في مقبرة القنيطرة السورية.
وإذا كان المغاربة يكنّون لصدّام حسين الكبير والكثير من المودّات بسبب تدخّل طيرانه وقتها للتنفيس عن الحصار المضروب على التجريدة المغربية، وبالرغم من تشابه النظامين، يسترجعون عكسياً انفعالهم إزاء النظام السوري، الذي زاد من ابتعاده عن الروح المغربية، لمّا كان أول من اعترف بما تُسمّى الجمهورية الصحراوية، التي تسعى إلى فصل الصحراء عن مغربها، وذلك في إبريل/ نيسان 0891، بعد إعلان ميلادها في تراب تندوف الجزائرية بأربع سنوات. وقد وجد الجيش المغربي العائد من الجولان بعد حرب ضروس في الجبهة السورية نفسه يتلقّى الطعنات والهجومات والقتل، من داعمي هاته الجمهورية ومليشياتها المسلّحة.
وبالرغم من وجود النظامَين في عهد الحسن الثاني وحافظ الأسد على طرفي نقيض عربياً ودولياً، كانت بعض المياه تجري بين العاصمتين بين الفينة والأخرى، كما في 1992 عندما زار الملك الراحل المقبرةَ التي تحضن جثامين الجنود الذين سقطوا في الجولان. ومع مجيء محمد السادس إلى الحكم (9991)، وبشّار الأسد)، 2000 (انفتح الأمل واسعاً في أفق جديد للعلاقة، ولا سيّما أنهما، إضافة إلى عبد الله الثاني، من بين ثلاثة قادة عرب جدد دخلوا المشهد السياسي العربي بآمال عريضة. في تلك الفترة، زار محمد السادس دمشق ()2001، وتوجّه إلى مقبرة القنيطرة للترحّم على الشهداء الجنود المغاربة.
وهكذا توقّع كثيرون في المغرب (وغير المغرب) مرحلةً جديدة، ولا سيّما مع بعض الانفتاح الداخلي في سورية، ولعلّ الأمل راود المغاربة في أن “يستطيع النظام تجديد نفسه”، خاصّة أنه قد عمد في سنة 2001 إلى إغلاق مكتب “بوليساريو” في دمشق، حتى لو لم يسحب الاعتراف بما تسمّى ”الجمهورية الصحراوية”.
ربما اختلف الامتحان الجيوسياسي في عناصره كما في تركيبته، لكنّ أحد أكثر الامتحانات أهميةً سلّط الودّ على اختيارات كلّ قائد منهما.
كان الربيع واحداً في الرباط وفي دمشق (2011)، وفي وقت بادر فيه العاهل المغربي بفتح آفاق المستقبل من خلال التجاوب مع الحراك الداخلي، وتفادى المغرب السقوط في الاستحالة السياسية، والميل إلى الحلّ العنيف للتناقضات الداخلية، عاكس قائد دمشق الجديد هذا التوجّه، وردع المتظاهرين بعنف، وظهر أن خيارات كلّ واحد غير خيارات الآخر، واتسعت الهوّة أكثر عندما استضاف المغرب، إبان كان الإسلامي، سعد الدين العثماني، وزيراً للخارجية، مجلس الوزراء العرب (16نوفمبر/ شباط) 2011، بحضور ممثّل تركيا، لبحث تطورات الملفّ السوري. وكان قرار تجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية في جدول الأعمال. وقابل نظام الأسد الموقف الديبلوماسي بأعمال بلطجة تعرّضت لها سفارة المغرب في دمشق.
وفي منتصف سنة، 2012 احتضنت مراكش الاجتماع الدولي الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، بمشاركة أكثر من مائة دولة عربية وغربية، وكان ضمن جدول أعماله الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ممثّلاً للشعب السوري. رسمياً سيقدّم المغرب قراءته الاسراتيجية لما وقع في قمّة الرياض، في إبريل/ نيسان 6102، أي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية، وأيضاً بعد دخول سورية حرباً أهليةً. وارتكزت قراءة ملك المغرب على ثلاث مقوّمات؛ ما تعيشه بعض الدول في العالم العربي “ليس استثناء، وإنما يدخل ضمن مخطّطات مبرمجة، تستهدف الجميع”؛ المنطقة العربية تعيش على وقع “محاولات تغيير الأنظمة وتقسيم الدول، كما هو الشأن في سورية والعراق وليبيا”؛ تحالفات جديدة قد تؤدّي إلى “إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة”. ما يعني أن القيادة السياسية في المغرب وضعت شبكةً واسعةً لفهم التحوّلات الجارية، ومن ثمّة تحديد الموقف منها، ولا سيّما ما يتعلّق بسورية التي تخندقت، بالقوة أو بالفعل، في خانة الدول التي عصفت بها التحوّلات الجارية.
وإذا كان المغرب رسمياً دعا (ويدعو) إلى احترام سيادة سورية ووحدة ترابها واحترام إرادة السوريين في بناء نظامهم، فهو لم يسارع إلى الاحتفال بما وقع في الأسابيع الماضية. والمؤكّد أن قطاعاً واسعاً من الرأي العام ابتهج بسقوط الراعي المشرقي لعناصر الانفصاليين الذين كانوا فوق التراب السوري، وتحت مظلّته العسكرية، وتحت إشراف قوات حزب الله التي دخلت في تحالف وجودي مع النظام، ورعت أجندته في المغرب الكبير من خلال دعم مليشيات جبهة بوليساريو. ويسعد الرأي العام المغربي لسقوط نظام وضع من دعم “بوليساريو” ثابتاً سياسياً في العلاقة مع شعوب المغرب الكبير، وامتداداً للسياسة المغاربية لطهران.
وفي سياق تحليل مواقف الأطراف المغربية، فوجئ المتتبعون بانقلاب الموقف لدى التيّار الإسلامي، بتشكيلاته كلّها، ولا سيّما الإخوانية، من إيران التي كانت تُقدَّم إلى حدود أشهر قليلة باعتبارها محور المقاومة الداعم لفلسطين، وكان أن كتب أحد الدعاة والمنظّرين للتيّار الإسلامي المغربي (انظر “إيران والفقيه الريسوني… غزّة في ميزان السنّة والشيعة”، “العربي الجديد”، 01/9/4202) يدافع عن شيعة إيران، وفضَّلهم على السنة في دعم الفلسطينيين و”حماس” في حرب غزّة، إذ تسارعت المواقف المباركة لوصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة. وتابع الرأي العام مواقف رموز التيّار الإسلامي، منهم وزير خارجية المغرب السابق، سعد الدين العثماني الذي تحمّل مسؤولية رئاسة الحكومة، وقبلها وزارة الخارجية، وكان مسؤولاً لحظة انعقاد مؤتمرَيْن اثنَين، واحد عربي والثاني دولي، لنصرة الشعب السوري. واتضح أن الموقف من إيران يتحدّد بحسب المناسبات، ”وضعياتي”، أي بحسب الأوضاع. كما يبدو أن العلاقة السيئة بين النظام السوري وجماعة الإخوان المسلمين، منذ أحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي، أيّام الأسد الأب، تمثّل خلفيةً حيّةً ما زالت تحرّك عواطف التيّار المذكور ومواقفه، كما كان الأمر عند تيّارات أخرى كانت تقترب من النظام على أساس مواقفه من المنافسين الأيديولوجيين لها.
كيف يبدو سقوط دمشق من شرفة في الرباط؟… تبدو المرحلة منفتحةً على احتمالات أفضل، وربّما سيكون تأثيرها جليّاً في منطقة المغرب الكبير، بفعل انحسار ظلّ إيران في المنطقة المحيطة بها وتراجع نفوذها في مجالها الإقليمي، وهو الأثر الذي سيمتدّ إلى الغرب الإسلامي، ويضعف أكثر حركة البوليساريو وداعميها الذين كانوا يعوِّلون كثيراً على نهاية الحرب في الشرق الأوسط لتقديم دعم أكثر قوة ونوعية.