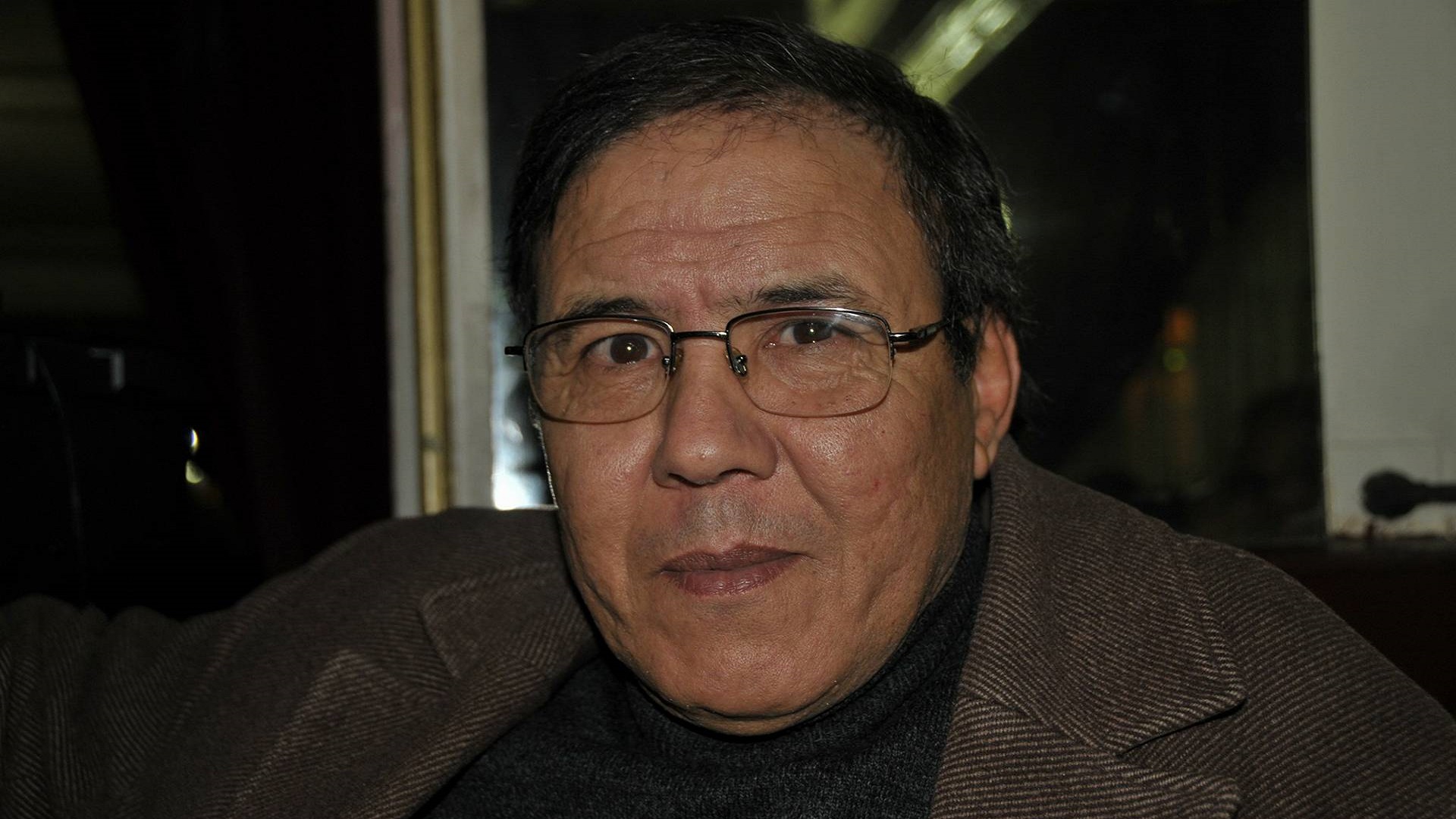كالعادة استيقظ في السادسة والنصف صباحا، لأن موعد العمل في المؤسسة البعيدة التي يشتغل فيها هو الثامنة. توجه إلى بيت النظافة. حلق وجهه، واتجه إلى المطبخ ليُعدَّ فطوره: خبز وزيت الزيتون والشاي. كان يزدرد هذه الوجبة التي ورثها من زمن الطفولة، حين انتبه إلى صمت مطبق لم يعهده قط، خصوصا أن في مثل هذا الوقت تتسرب عبر نوافذ البيت أصوات هدير محركات السيارات ومنبهاتها المزعجة. ترك ما هو فيه من أكل، وتوجه إلى الشرفة المطلة على المحيط الخارجي.
كان الشارع فارغا تماما من المارَّة، ومن حافلات وسيارات النقل العمومي. كان فارغا أيضا من الدراجات النارية، والسيارات. شك في الأمر، وهمس لنفسه التي اجتاحتها حيرة عارمة ” ربما يوم عطلة، وأنا لا أدري، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يكون الشارع خاليا من الحركة على هذا النحو. ” عاد إلى اليومية، وتأكد أن اليوم هو الجمعة، ولا عطلة فيه تُعفي الناس من العمل. ازدادت حيرته، واستشعر بعض الخوف.
أراد أن يتأكد مرة أخرى فهرع إلى الشرفة. كان الشارع أخرس كقبر، وما أثار حيرته أكثر هو أن الأشجارــ التي تعنفها الريح في مثل هذا الفصل، لا حركة فيها، كما أن أسراب الطير التي تخترق المدى، بين الحين والآخر، اختفت. كاد أن يبتسم لمزحة هتف بها صوت من الداخل: ” ترى هل الطيور أيضا في عطلة؟ “
قرر أن ينزل إلى الشارع بسرعة من دون الاهتمام بهندامه. أسَرَّ لنفسه: ” مادام الشارع خاليا من الناس فما الجدوى من الهندام؟ “مشى بعض الوقت دون أن يصادف أحدا. حتى القطط والكلاب الضالة اختفت هي الأخرى كما لو أن الأرض ابتلعتها.
خطرت له فكرة التوجه إلى الشاطئ، الذي ليس بعيدا من الحي الذي يقطن فيه. وجد وجه البحر صفحة زرقاء وخطها البياض. لا موج ولا هدير. لا سفن عابرة، ولا شراع. هل البحر هو الآخر أصيب بالعطالة والخرس؟
نظر إلى الأفق، الذي عادة يدمن التأمل فيه. كان عبارة عن بطاقة بريدية جامدة. فكر في أن يتصل، من هذا الصمت المريب، بأحد الأصدقاء. لما بحث عن الهاتف المحمول في كافة جيوبه لم يجده. تأكد له أنه نسيه في البيت بسبب الإرباك الذي هو فيه. ازداد خوفه، فاستشعر نقطة من العرق تنزل باردة من أعلى الظهر متخذة من العمود الفقري مجراها باتجاه الأسفل. تمنى لو أن الأمر كان كابوسا فقط، وأن هذه التجربة إنْ هي إلا أضغاث أحلام.
عاد إلى البيت على وجه السرعة، لأن الخوف تحول إلى رعب تعرَّق بدنه، وبأصابع مرتعشة شرع في مهاتفة زميل له في العمل. الهاتف يرن، ولا أحد يجيب. اتصل بالثاني والثالث. لا أحد. لا صوت من هناك. وحده الصوت الأنثوي الآلي يجيب: “لا أحد منخرط في هذا الرقم الذي تطلبونه.”
تلاطمت الأفكار بشكل مشوش في ذهنه، وساورته الظنون. سأل نفسه: “من المفيد تدوين هذه التجربة، ونشرها في زاويته الأسبوعية في الجريدة.” صمت قليلا، وهو يفكر، “كم أنا أبله. ما الجدوى إن كان القارئ المفترض لا وجود له؟”
اقتنع أخيرا بضرورة الكتابة بعد أن اتضح له أن ما سيكتبه، من دون شك، سيقرؤه أحدهم نجا من هذه الأعجوبة التي لم يجد لها تفسيرا. تأكد له أنه لن يكون الوحيد الذي سَلِم من هذه اللعنة التي حلت بالمدينة. قد يكون ثمة شخص آخر، أو أشخاص يمرون بنفس التجربة. احتمال صحة هذه الفكرة وارد، لذا استشعر بعض الطمأنينة.
لما شرع في الكتابة على ورقة ناصعة البياض انتبه إلى أن المداد الأسود تحول من تلقاء ذاته إلى مداد أبيض. بدا له أنه كمن يكتب على الماء. حاول، بلا جدوى، أن يعيد قراءة ما كتب، لأن السطور كانت تتآكل، كما لو أن أرضة تقضمها بسرعة فائقة حرفا حرفا.
أصر على الكتابة، وانتابته رغبة عارمة في تدوين تلك التجربة الفريدة من نوعها. استشعر رجفة القلم بين الأصابع إلى درجة استحالة الكتابة. تلا ذلك إحساس كبير بالتعب، ورغبة عميقة في النوم. قبل أن يستسلم لتلك القوة الغامضة الجاثية ثقلا عارما على جفنيه. هتف لنفسه بشيء من الأسى: “ها أنذا ألتحق بدوري بالصمت المريب، وما يشبه الموت.”
استسلم لثقل جفنيه، وشعر بجاذبية لا تقاوم تسير به على مهل إلى فوهة نفق غامض ورهيب. هنيئة قصيرة فقط كانت كافية ليخرج من ذلك السرداب الطويل. تغير المشهد تماما ليجد أمامه مساحة شاسعة من الضوء، الذي لم ير له مثيلا. ذات الضوء بدأ يتجمع حتى غدا كرة ضئيلة في حجم الكف. انحسار الضوء فسح المجال لمراع خضراء، لكن لا كائن فيها، ولا حركة. كان الامتداد فقط، والصمت الرهيب.
وهو مستغرق في ذلك المشهد الغريب، سمع صوتا آت من بعيد. بدأ ذلك الصوت يقترب تدريجيا إلى أن أصبح له وقع قوي على طبلة الأذن. فتح عينيه. كان الصوت عبارة عن رنات مصرة متتالية لمنبه الساعة. أسكته على الفور، وظل في الفراش لعدة دقائق يستعيد العالم الغريب الذي كان ضيفا عليه. كانت دقات قلبه تكاد تسمع، وانتبه إلى الفراش المبلل بالعرق.
قبل أن ينهض من السرير شك برهة في أنه فعلا حي يرزق، وقبل أن يذهب إلى دورة المياه، ثم المطبخ، كما يفعل عادة، توجه رأسا إلى الشرفة. شعر بفرح غامر، وهو ينظر إلى السماء بدهشة، كما لو أنه يراها لأول مرة.
كان الشارع العام يعج بالحركة، والناس، على الرصيف، يعبرون مهرولين إلى أعمالهم ومشاغلهم. الأشجار تعنفها رياح فبراير الغاضبة، وسرب طير يعبر المدى البعيد. هتف بغبطة: “لا شك أن كل يوم جديد في حياة كل إنسان يعتبر معجزة حقيقية.” صاح بملء الصوت في أعماقه: ” المجد لك أيتها الحياة، المجد لك أيتها العظيمة.”
بعد أيام قليلة قرر التوجه إلى عيادة طبيب القلب المجاورة لمسكنه من أجل فحص دوري روتيني. هذا الفحص دأب عليه كل ثلاثة أشهر لأن نبضات القلب غير منتظمة. أنجز له الطبيب، كما العادة، فحصين هما: التخطيط والإكودوبْليرْ، وانصرف إلى بيته مع ما يكفي من شكوك وظنون.
في الغد، قبل أن يستلم نتيجة الفحص، نظر إليه الطبيب من وراء مكتبه بعض الوقت. بدا الطبيب كما لو أنه متردد في الإفصاح عن شيء ما يودُّ قوله.
_” قل لي من فضلك أستاذ، كيف هو التخطيط هذه المرة، ونتيجة الفحص بالصدى؟ “
سكت الطبيب برهة، ثم أخذ نفسا، وقبل أن يجيب عن سؤال زبونه، مد يده مصافحا:
” عْلى سْلامْتَك. ”
وأخبره أن في الليلة كذا، وعلى الساعة كذا توقف القلب عن الخفان لثوان معدودة، وأنه ساعتها كان في عداد الموتى.
خرج من العيادة، وعلى وجهه بقايا فزع مما أسَرَّ له الطبيب. توجه، على وجه السرعة، إلى المكان المفضل لديه. توجه إلى الشاطئ واهب السكينة، والشعور بالطمأنينة وراحة في النفس والروح.
تأمل البحر، فبدا له أنيسا هائلا، ورفيقا بقدر ما هو عريق في الأزل، فهو عريق فيما سيأتي من الأبد. مشى بعض الوقت على الشاطئ الفارغ من الناس، لأنهم لا يرتادونه في مثل هذا الفصل من السنة. لا يرتاده غير قلة قليلة من العشاق، وبعض الباحثين عن لحظة يخلون فيها بذواتهم، ويرتبون فوضاهم الداخلية، وما يصطدم في أعماقهم من رغبات وحاجات إلى حد حدوث شرخ بين الأنا وذاتها، وبين الأنا والآخر. ظلت هذه الأفكار تراوده، وهو يمشي، إلى أن وصل إلى صخرة اعتاد الجلوس عليها.
أمام شساعة امتداد البحر استعاد كابوس تلك الليلة الرهيب الذي لم يكن أضغاث أحلام، بل كان شروعا فعليا في الرحيل. تحسس، قلبه بيده اليمنى. ظل يفعل إلى أن استشعر فرحا آت من الأعماق، فهمس لنفسه التي استعادت بعضا من طمأنينتها: ” لا شيء في الوجود أعظم من الحياة، لا شيء في غيابها له قيمة تذكر، ولا شيء بعدها يهم.”