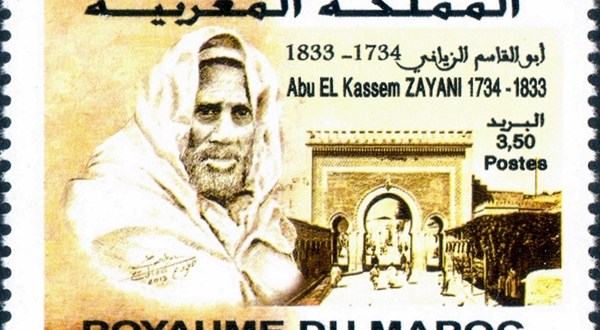
كتبه: عبد الدين حمروش

كانت بداية نكبات الزياني، كما كان يحب أن يصف معاناته، منذ رحيله، رفقة والديه، إلى الحجاز. لم يكن ذلك اختيارا، رغبة في النزهة بالأقطار، أو تشوفا إلى زيارة الحرميْن بالدرجة الأولى، وإنما فرارا من ظروف العصر المضطربة، على عهد السلطان المولى عبد الله. وقد أخبرنا الكاتب المؤرخ عن سبب رحيله ذاك، على غرار كبار الأدباء والعلماء، الذين أنفوا من تَقلُّب أحوال أزمنتهم واضطرابها، بالقول الواصف الدقيق التالي: ” وسياق الأولى أني توجهت مع والدي وسِنّي ثلاث وعشرون سنة بقصد أداء الفرض والمجاورة بحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سئم المغرب والمقام به، لتبدُّل أحواله عما كان يعهد، ففرّ بدينه، وهيأ أسبابا وأنا مُساعدُه على شأنه”.
والملاحظ أن شكوى الزياني من ارتباك أحوال عصره، وتذمُّره من سقوط أهل زمانه، لم يكونا طارئين لديه لهذا السبب العابر أو ذاك، وإنما كانا نابعيْن من أصالة أبيّة في نفسه، لا تقبل بالأمر الواقع الشائن، ولا تُطبِّع مع انصرام أهل الفضل البائن. وقد جاء، في إحدى فقرات “الترجمانة”، ما نصُّه: ” إني أستغفر الله من الذنب الذي يكون سببا في الخروج عن المسالك، إلى الوقوع في المهالك، وذلك سبيل من يركب بنفسه الأخطار، ويرغب في زهرة هذه الدار (…)، سيّما في هذا الوقت الذي صغرت فيه الهمم، وكسدت سوق صاحب السيف والقلم، وطفا فوقه السّفيه والعاطل والخامل والجاهل، وسادت أحوال أهله وشالت نعامة فحله، وقلّ خيرُه وكثر شرُّه، وغلب بره فأجره”.
في انقلاب الحال إلى السوء، كان يلتقي العامة والخاصة، من أهل بلده وزمانه، على حد سواء. وإن اصطدم الكاتب أبو القاسم مع رجالات عصره، من المؤرخين والعلماء والسياسيين، في حالات بعينها ملموسة، إلا أنه كان له أن ينتهي إلى مثل هذه النتيجة الحاسمة، التي جمع فيها مُعاصريه من أهل الطبقة الثالثة من الطلبة والكُتّاب، على حد وصفه إياهم، بقوله “المُحبِط” التالي من “البستان”: ” وعلمت أنه لم يبق بمغربنا من يعتبر ما يسدي إليه من الإحسان، ويرى المكافآت عليه ولو بمجرد اللسان، خصوصا أهل هذه الطبقة الثالثة من الطلبة والكُتّاب، الملازمين لتلكم الأعتاب، الذين اقتنوا فيها الأموال والدور (…) ولم يوجد منهم محسن لا حسن (…) لكن أهل وقتنا هذا كما قيل: “من أحيى شرار قوم أماتوه، ومن سابق لئاما فاتوه، ومن زرع السباخ أتلف بدره، ومن رفع الأخلاط جهلوا قدره”.
واقع الحال، الذي وصفه الزياني أحسن وصف، ظل يتأكد مع ما كان يشيع من دسائس ومؤامرات نصبها البعض للبعض، داخل بلاط السلطان وقصوره. إن تصفُّح كتُب العصر مليئة بالدسائس والمؤامرات. هل الأمر يتعلق بعصر دون عصر؟ وببلاط سلطاني دون بلاط آخر؟ الرجل نفسه يجيب بطريقة غير مباشرة، حينما أفرد في “الترجمانة” مقتطفات عن الحسد. الأمثلة والشواهد عن المؤامرات، التي غالبا ما كانت بدافع التنافس والحسد، عديدة في مؤلّفات الكاتب. وفِي ما تعلق به، فقد حكى في “الترجمانة” ما تعرّض له على يد بلقاسم الزموري، الذي كتب إلى السلطان سيدي محمد بأن الزياني هو الذي أفسد عليه القبائل، ما جعله ذلك يعيش “في خبر الإهمال”، يتوقع الموت كل يوم.
ومما يجب الإشارة إليه، أن خصوم كاتب سيرة السلطان، سيدي محمد بن عبد الله، توارثوا خصومته أبا عن جدّ. وفي سياق هذه الخصومة المتوارثة، بل العداوة المكينة، ضد “الرجل، ننقل عن الأستاذ هاشم العلوي القاسمي، من “المدخل” الذي وضعه لـ “البستان الظريف”، ما يلي: ” ولعل موقف مُعاصريه منه أثّر على سُمعته مثل غمزات مُنافسه “أكنسوس” في “الجيش العرمرم”، وبعض خصومه من أهل فاس، ممن بقي إلى ما بعد وفاته، ويظهر ذلك واضحا في ترجمة الكتاني لأبي القاسم الزياني في “سلوة الأنفاس””.


