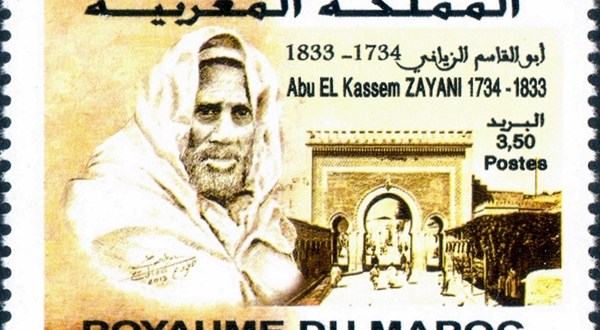بقلم: عبد الدين حمروش

ليس في الأمر مزحة على الإطلاق. من منكم لم يجد نفسه في موقف الباحث عن تواليط، أو “الكابينة” بلغة العامة من المجتمع، أو “المرحاض” بلغة تلاميذ المدرسة، أو “الميضة” بلغة أهل البادية في مناطق معينة، أو “الحمام” بلغة أهل الحضر اليوم؟ على الرغم من كل ما قد يثيره الموضوع من تحفظ، قد يصل حد الإحجام عن الخوض فيه، فإن إثارته لها “موقع من الإعراب” في سياقنا. التواليط، من المواضيع التي يكون الحديث عنها بخفض الصوت، فأحرى بالكتابة عنها جهرا. الجميع يريد التواليط، لكن هذا الجميع يتحاشى الحديث عن التواليط، كشأن عام في إطار النقاش العمومي، إلا فِي ما ندر. بالمناسبة، سمعنا، خلال هذه الأيام، عن اعتزام المجلس البلدي، بمدينة المحمدية، إنشاء موقف تحت الأرض للسيارات. ويا للأسف، لم نسمع أنه يعتزم إنشاء تواليطات للعابرين، من أصحاب السيارات أو من الراجلين. حتى تواليطات شاطىء المركز فُتحت أبوابها مدة، مثل هُدن الحروب، ثم عادوا فأغلقوها. هل هناك مشكل لمجلسنا الجماعي الموقر مع التواليطات العمومية؟
ثم لماذا يُصرف المال العام من أجل إنشاء كابينات تواليط، وبالإمكان الاختلاء بالأمكنة الطلقة لقضاء الحاجة، بعيدا عن أعين المترصدين والمتربصين؟ هل حدث لبعضكم هذا، أي أن كنتم في حاجة إلى تواليط، ولم تجدوها إلا في مكان خرب قفر، أو تحت جذع شجرة ضخم؟ لا تقولوا لي لا.. لم نفعل ذلك في حياتنا قطعا. ثقافة الاختلاء، وبخاصة في البادية، مازالت مستمرة إلى اليوم. من منكم ظل يفضل الخلاء الواسع المفتوح على التواليطات العصرية المغلقة، ذات الكرسي الأبيض من الفايانس؟ إن كان ولابد منها، فبشرط اتقاء كلاب البادية ولو كانت أليفة، وبرفقتها الذباب الأزرق، ذو الصوت الهزج، مثل ذباب عنترة. كان الخلاء حلّ من لا حل له. وكان الحجر أيضا. في البدء، كان.. وقد خرج مُباركا من الجنة مثل “العصا”، حين لم يكن كلينيكس الناعم قد خرج بدوره من العدم. لقد حدثت طفرة كبيرة للمغاربة، في الانتقال من الحجر، فإلى أوراق الدفاتر التي فات أجل امتحان أصحابها، ثم إلى كاغيط كلينيكس. غير أن ورق كلينيكس الناعم المرهف، المزدهي بألوان قوس قزح، غالي الثمن. اسألوا مهاجرينا، الذين يعودون إلينا كل صيف، وفي خلفيات سياراتهم رولوات كلينيكس. لا أدري كيف لبلاد تصنع السيارات، وتصدرها إلى العالم بأسره، وتفشل في صناعة الورق، لكي “يمسح” مواطنوها و “يقرؤون”، مثل باقي مواطني العالم المحترمين. حكوماتنا لا تحبنا، لأنها لا تريدنا أن نمسح كما نقرأ، أو بالأحرى نقرأ ثم نمسح. ألهذا ترمي بنا إلى الخلاء، كما ظلت ترمي بنا إلى التكوين المهني؟
ومع ذلك، فالسؤال يظل مطروحا بالنسبة إلى بعضنا الآخر. هل يحدث أن تختلي النساء والفتيات في أرض الله الواسعة المفتوحة؟ كيف يستطعن ذلك، بالمقارنة مع الرجال، حتى ولو اشتدت بهن الحاجة. هل فكرنا فيهن يوما؟ حكت لنا فاعلة سياسية ليبية قدمت من بنغازي عبر الحافلة، على أمل أن تستفل الطائرة من طرابلس إلى الدار البيضاء. ماذا حكت لنا، وقد كانت ترافقنا من مراكش إلى البيضاء، بعد أن شاركتنا ندوة منظمة بالمدينة الحمراء؟ حكت لنا عن التواليط “المفقودة”، التي لم تعثر لها على وجود، طوال الطريق بين بنغازي وطرابلس. لم تكن تريد، وهي المرأة، إضافة إلى نساء أخريات، إلا التواليط. جميع الحاجات الأخرى، بما فيها الأمن، بُعيد سقوط نظام القذافي، قُضيت… إلا الحاجة إلى التواليط. هل هذا شيء كبير في حق حرائر ليبيا؟ الرجال يختلون في الصحراء، الممتدة بين شرق ليبيا وغربها، لكن أين تختلي النساء، حين يضيق بهن مكان آمن في صحراء برقة؟
لقد كانت السيدة الليبية مطمئة، حين أخذنا قسطا من الراحة، في محطة استراحة بالأوطوروت. ذهبت إلى التواليط، وأخذت وقتها، ثم عادت سالمة غانمة. اقتعدت مقعدا خشبيا، حول طاولتنا الجماعية، ثم أطلقت قنبلتها.
– لِعِلمكم، لقد تطور المغرب كثيرا، ولم يعد تفصله إلا خطوات عن أوروبا، مثلما لا تفصله عنها إلا طلة من البوغاز. ألأن المغرب صارت به تواليطات، هذه المزروعة على امتداد الطريق السيار بمحطات الاستراحة، من أجل سلب الناس أرزاقهم، عند اقتناء كأس قهوة باهظة الثمن؟ ضحكنا من استنتاجها هذا جميعا، حيث وجود التواليط من عدمه، بات معيار التقدم في المدنيّة لديها. المغرب تقدّم في سلم المدنيّة، ولم نكن نعلم بهذا إلا تلك اللحظة، على لسان زائرتنا الليبية. ومع ذلك، فهل كانت التواليط مطلبا سهلا، بالنسبة إلى الفاعلة السياسية، وهي المسافرة من مدينة إلى مدينة، وبينهما مسافات بعيدة من الفيافي والقفار؟
هل حدث لواحدة منكن أن عاشت محنة الكاتبة السيدة الليبية؟ إذا تغاضيتن عن الجواب، باعتبار الأنوثة التي تحاصر معظمكن، فأنا (الرجل…ههه) من الجرأة التي لا أخفي بها ما حدث لي يوما. المكان بجنيف، أما التاريخ فلا يقل عن أربع سنوات انصرمت. كنت في زيارة ابنتي بليون الفرنسية. وبحكم قرب المدينتين، فقد قررنا اجتياز الحدود الفرنسية إلى الأراضي السويسرية. جنيف، مدينة جميلة، لكنها غالية. هي أكثر تمنُّعا على المهاجرين في الظهور بها. أو بالأحرى، لا يظهرون فيها كما يظهرون بليون، التي أعرف شوارعها وساحاتها. أحسست أني أبدو غريبا بجنيف. ترى، لماذا خالطني هذا الإحساس يومذاك. لا أدري لماذا رافقني، وأنا أتسلل إلى تواليط إحدى المقاهي خِفية. حمدت الله أنني لم أجد باب التواليط مُغلفة بالمفتاح، كما الحال في بعض مقاهينا. دلفت إلى “الة”، حامدا الله أنني لم أتوسل إلى النادل كي يفتح لي الباب، أو يسلمني المفتاح من يد ليد، لأعيده إليه بعد قضاء الحاجة ثانية، كما يحصل عندنا في مرات كثيرة.
– واو..
– لقد كانت التواليط السويسرية أنقى من مرآة الغريبة وأجْلى. وجهك فيها على الزليج، المصفف على الأرض أو الحيطان، كما لم يسبق أن رأيتَه من قبل. إن أردت اختبار درجة مدنيّة أي شعب، فادلف إلى التواليطات في أماكنه العامة والخاصة. من أسماء التواليط المجازية عندنا، في أقرب زمن فائت، “بيت الراحة”. إن كان هناك من بيت للراحة، ولجت إليه في حياتي التي قاربت الستين، فلن يكون سوى البيت السويسري الأنيق، البديع والجميل. هل نسيت نفسك؟ قم، واخرج قبل أن ينتبه إليك أحدهم. وأين المفر من هذه الشقراء الحسناء، الفارعة الطول، التي تشتغل نادلة بالمقهى؟ لا مفر من ملاقاتها وجها لوجه.. بل لا مندوحة من النظر في إقبال وجهها، والتملّي ببهاء طلعتها، والغوص في ازرقاق عينيها. كل تقريعاتها لي، نتيجة التسلل بدون إذن، لن تنال من معنوياتي قيد أنملة. هكذا. وَقَرَ لدي، أنا الغريب الطارئ.
– الحق في التواليط مشروع، آنستي الفاضلة. ولا يحتاج إلى طلب إذن، وبخاصة بالنسبة إلى من اشتدت به الحاجة.
– ثم ماذا عساك أن تصنعي لي، حيث أدنى حقوق الإنسان في أوروبا “الحق في التواليط”؟أليس هذا صحيحا؟
استعجلتني ابنتي، من خلف واجهة المقهى الزجاجية، للخروج توًّا. قالت لي: كل شيء، هنا، بثمن يا أبي. على أسعد حال، خرجت خفيفا، مثل الورقة في مهبّ الريح. الآن، أضحى الاستعداد للعودة على أكمل ترتيباته. اتقاء مشاق الطريق، وما قد تفاجئك به الحاجات الماسات، كلها أمور مطلوب الاحتراس منها، قبل ركوب الحافلة. في هدوء تام، وبثقة عالية، أخذت مكاني. ياه، كم هي الثقة ضرورية لاستواء شخصياتنا، واعتدال أمزجتنا. وجزء من الثقة في النفس مُرتبط، طبعا، بالتخلص من وسواس الحاجة المفاجئة إلى التواليط. والحافلة تنهب الطريق المستوية نهبا، مثل بساط التشريفات الرسمية، عادت بي الذاكرة إلى أول رحلة، قمت بها إلى فرنسا عبر “الكار” أيضا. بحكم طول الطريق، عبورا من إفريقيا إلى أوروبا، كنا نستريح – نحن الركاب – في هذه المحطة أو تلك. وكلما نزلنا محطة، اجتحنا تواليطاتها كالجراد. نستهلك ورق التواليط بإفراط، بل كان منا من ” يهرف” منه على أكثر من ” لفّة”، يَلفُّها حول مجموع كفه، لتلافي “مفاجآت” الطريق (ههه). لماذا كل هذا “الهريف” على كل شيء، نجده بالمجان أمامنا، والمبالغة فيه؟ كل ما هو مجاني يثير شرهتنا، حتى بالنسبة إلى من هم من غير ذوي الحاجة إليه، مثل عُشاق حلويات برلماننا الأغر. هل تذكرون؟ آه، كم كانت حلويات حفل البرلمان مقرمشة ولذيذة. والكارثة أننا لم نكن نترك مكانا بمقهى إلا استعمرناه، من دون حتى أن نصرف ولو ثمن كأس قهوة. ولماذا نصرف أموالنا على هؤلاء القوم، ومنا من استقدم معه دجاجة بكاملها، ليأكلها على مدار أكثر من يومين، طيلة مسافة الرحلة؟ نحن نلتهم دجاجاتنا المعبأة بـ “الدغميرة”، والآخرون يستقبلون “بيضاتها” المزكرشة، على الرحب والسعة، في تواليطاتهم. أمازلتم تريدون أن تعرفوا لماذا تزداد العنصرية ضدنا درجات في بلدان أوروبا؟
آخر ما نفكر فيه هو نظافة التواليط. أقصد التواليط العمومية بالتحديد. بقدر حرصنا على نظافة التواليطات ببيوتنا، نجد أنفسنا أبعد من أن تتحرك لنا شعرة، إزاء قذارتها في أماكننا العمومية. في معظم المقاهي، المكان الأشد ظلاما، والأكثر ضيقا، والأنتن هواء، هو المخصص للتواليط. إن كان هناك من عقاب جماعي لنا، فهو ذاك المسلط علينا في التواليط، وبالتواليط. كنا طلبة في مدينة غير مدينتنا، وكان زميل لنا ظريف، اسمه المامون، يصف ضيق تواليط مشتركة مازحا: إما تدخل أنت أو يدخل ” المقراج”. معاً، أي أنت والمقراج، يستحيل الولوج إلى المكان. ومع ذلك، التواليط الضيقة ليست بمشكل كبير. المشكل في أن تدخل إحداها، فتجدها “مخنوقة” مثل الجيفة، تطفو على سطح مياهها فضلات بني آدم. وأنت تجثو على ركبتيك كالمقرفص أو تكاد، يلزمك أن تظل في حالة استنفار. كلما أحسست بـ “بعض” منك يهوي، عليك أن تحتاط كل الحيطة، حتى لا يتطاير الرشَاش من خلفك، فيعلق الماء القذر بأطراف ثيابك. إن معرفة المسافة، بين منطلق السقطة وفوهة دورة المياه، ضرورية في حالات الاحتياط هاته. أحسن طريقة لتفادي مثل هذه “الاختناقات المرورية”، تم اكتشاف “الدرهم” المخزني، ومعه جابي هذا الدرهم. عند باب كل تواليط حارس، يسهر على سلاسة المرور بدون مشاكل. في الغالب، تكون امرأة “غاب” عنها زوجها، وإلا فرجل من جميع الأعمار. في بلادنا، يبدأ الحارس من التواليط إلى موقف السيارات. وفي حالة حراس السيارات على جنبات الشوارع، العشوائيين الذين لم يعودوا يقنعون بالدرهم الواحد، تحت وطأة التضخم الذي لم يترك سلعة أو خدمة إلا زاد في ثمنها، لا أحد بات يفكر بالزيادة في الدرهم اليتيم لحُراس التواليطات المساكين.
النظافة من الإيمان. هكذا، تعلمنا أن نتأسى، ونعتبر في حياتنا. ولكن، قليلا ما كنا نأخذ شعار النظافة على محمل الجد في حياتنا العامة. قالوا إن العرب المسلمين هم من لقنوا الأوروبيين النظافة. هم من أرشدوهم إلى استحداث الحمامات، يوم كانوا يدارون روائحهم النتنة بالعطور. ألهذا اصطنعت فرنسا عطورها “الباريسية”؟ والمغرب يستعد لتنظيم كأس العالم، عبر تشييد الطرقات، وخطوط التيجيڤي، والقناطر المقنطرة، يُلاحظ أنه لا يأتي على إنشاء تواليطات عمومية. كيف لعشرين مليون زائر تقريبا، وأغلبهم سيكون “سارحا” في المقاهي والمطاعم والساحات والطرقات، في أفق 2030 التي تطل علينا برأسها، والبلاد في خصاص شديد إلى التواليطات؟ بمفردها، التواليطات المخنوقة ستجعل البلاد جاثية على ركبتيها، في انتظار ألا تقع مصيبة لا قدّر الله. الموضوع جدي، من هنا حتى 2030. وإلى ذلك، فنحن ندرك، ومعنا جميع المغاربة يدركون، أننا إن لم نعالج معضلة التواليطات، قبل الموعد المضروب، فإننا لن نرى لها أفقا للحل، في أي وقت آخر، بعد ذلك.
وقد أعذر من أنذر.