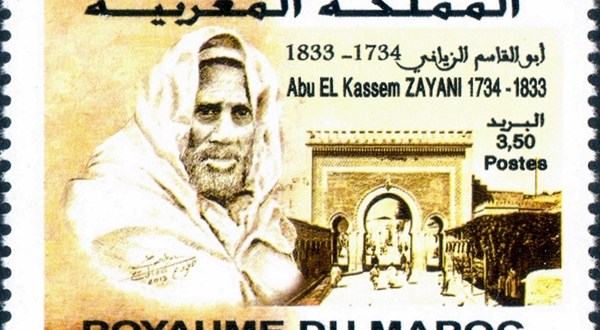بقلم: عبد الدين حمروش

– يا بابا، أرجوك. لا تعد إلى فتح أي رابط يأتيك. ففي كل رابط، لا تعرف من أرسله، قد يحمل إليك قنبلة تنفجر في وجهك. المرة القادمة، لن أسعفك بشيء. اتّعظ.
ومع ذلك، تظل أصابعي ” تأكلني” إلى أن أفتح الرابط. لم أكن أعلم أن الدودة تدبّ نحو أطراف الأصابع. الحمد لله أنها لم تبرحْها، وإلا فإنها الكارثة الكبرى قد حلّت، إن انتقلت إلى موضع آخر. أعتذر لكل من أحس بأي ” تعريض” غير مقصود، وبالتحديد من ذوي الأقواس القزحية الخاصة. طبعي البدوي، لا يقبل إلا الأبيض والأسود، مثل جورج بوش الابن القائل (والقاتل معاً): إما تكونون معنا أو تكونون مع غيرنا. لدى أشقائنا المشارقة، للدودة دلالة سلبية حاطة من ” الرجولة”، مثلما هو الحال عندنا في المغرب أيضا. من المشرق إلى المغرب، يوحدنا الخوف من الدودة.
الدودة أكلت مؤخراتنا صغارا. هم لهم دودة القز التي تمرح بناعم الحرير، ونحن لنا دودتنا البيضاء التي أتت على أمعائنا الخرٍبة. اسألوا الكاتبة لطيفة عن هذا. هي تعرف الدودة التي تداهم الصغار حق المعرفة، ولها الكثير مما تحكيه عن الموضوع. تعرف الدودة ودواءها بالترومبا. لا أدري ماذا يغري الدودة فينا. أهي “الحلاوة” فعلا؟ ومن أين لنا بها، ولم نكن نأكل لا شوكولاطة ولا مُربّى؟ وحتى إن وجدنا حبة ثمر وأكلناها، نجد دودنا الأبيض قد سبقنا إليها. أبي كان يقول لنا: لا ضير في ذلك، كُلْها ولا تخش شيئا، مُعتبرا بقول: “دودو من عودو”. كنا نأكل الدود الأبيض، انتقاما منه، حين يبالغ في التهام مؤخراتنا. أي نعم، كنا نأكله، مثل الجراد وحشرات أخرى، حتى قبل أن يُنصح بتناوله اليوم، لبروتيناته الغنية المعترف بها علميا.
آه، نسيتُ. إنها قطع “القالب” البيضاء، المركونة بعجائبها في “الربيعة”، الشبيهة بعجائب “الصفريوي” القابعة في صندوقه، ولم تبرحه منذ سنوات دراستنا الأولى. كلما احتجنا إلى بعض فيتامين حلاوة في حياتنا المُرّة، إلا اتجهنا، توّا، إلى القالب الأبيض المُقبب، أو على الأقل “دقيقه” الحلو الناعم العالق بالـ “الدكاكة”، الحادة الرأس من جراء كثرة الدقّ. ومع ذلك، فليست هناك حلاوة أكثر من ذلك الدقيق العالق. الحاجة الطبيعية إلى فيتامين حلاوة، كان يقودنا إلى “الربيعة” مباشرة (الصندوقة الخشبية المربعة). خلال إحدى المرات، حيث الربيعة مغلقة، أو مختفية عن الأنظار، اتقاء السطو والنهب المُفرطين، أتى أحدهم على علبة مُربّى مشمش بالكامل، يوم قادها حظها التعس إلى بيتنا. كان مربى المشمش، وقتها، هو السائد فقط. أما مربى التوت، فلم يظهر إلا حديثا، لغاية وحيدة: استنزاف ما تبقى من مياه الفقراء الجوفية. علبة المربى اختفت منذ خمسين عاما، ولم نعرف من لهفها لهفة واحدة حتى الآن.. كانت جريمة مكتملة الأركان. دقيقة ومحكمة. وقد مات من مات، فعند الله يختصم الفرقاء.
الدودة تنتقل من مؤخراتنا صغارا إلى أصابعنا كبارا، في ظل الطفرة المعلوماتية الحاصلة في زماننا. من لم تأكله الدودة قديما، فقد عادت لتأكل أصابعه اليوم. فليس من مفر إلا أن توسِّعوا لها، كثيرا أو قليلا، حسب طاقة كل واحد. كلما شُغّلت الهواتف، وفُتحت الروابط، إلا كانت لكم الدودة بالمرصاد. الدود الإلكتروني صار يغزونا.. تماما، مثلما تنبأ بذلك أكثر من فيلم، من أفلام الخيال العلمي، أو الرعب العلمي. لا فرق.
يأتيك الرابط نحيفا على متن موجة خفيفة زرقاء. لا يمكن إلا أن تفتحه، على أمل أن يحملك إلى عالم أزرق حالم. فما في عالمنا الحالي إلا القرف والبؤس والضجر. من لا يسعى إلى الجديد في كل يوم، حتى ولو كان خبرا بائتا، أو نكتة حامضة، أو صورة مُنفلتة؟ الطري الطارئ بالمغامرة أفضل من القديم بالعادة، حتى لو كان رصاصة في الرأس. فما عسى أن يأتي مع فتح الرابط الأزرق، إن لم يكن الجديد الطازج، الذي من شأنه أن يضفي قدرا من الحيوية على يوميّاتنا الرتيبة. إذا كان الفضول لا يقف عاجزا أمام إغراء الشريط الأزرق، حيث صار يحمل اسم الرابط ” الزغبي”، على أساس أن الواحدة منه هي ” الربطة “الزغبية”، فكيف يكون موقفك من صندوق الهدايا الكارطوني المُلوّن، والمُغلق بخيوط حرير ناعمة؟
– هدية جاءتك، مُتهادية على موجة زرقاء، ممن يُعزُّك. يعرفك بالاسم الكامل، ويقصدك على العنوان الثابت، ويداهمك بمقر العمل القائم. وهو بإرساله العلبة الجميلة، كعلبة الشكولاطة المفقودة في طفولاتنا القاسية، لا يريد إلا أن يبشّرك بجدول الزيادات في الأجور، المخبوء في جوفها الكارطوني الصقيل. قد يفاجئك بمزحة. لا أقل ولا أكثر.. ولا بأس. هل تتردد في فتح العلبة، المحمولة فوق قارب الرابط، مع أنك تتوقع أن تحلّق الملائكة، محيطين بالمسيح وأمه، من حواليك، أعلى قليلا؟ احذر، يا بابا. حسن النيّة يؤدي إلى الجحيم في أحيان كثيرة؟ ولكن، ألم يقل المغاربة، بالمقابل، ” المعروضة من الخير”. قل باسم الله، وافتح يا سمسم. هذه المرة، الإبهام تأكله الدودة أكلا، إلى أن تقرر في الأخير ” البصم” على الرابط. وبشكل مباشر، وفي سرعة البرق، تنفجر في وجهك كُتل طريّة من اللحم الأبيض. بنات سيدنا عيسى على الجادات، وإن عُلم أن الأخير لم يتزوج، ولم يخلِّف. زُفّ إلى السماء أعزب، مثل الشهداء العُزّاب. أو لم يتزوج المسكين، فعلا، وهو الإله ابن الإله؟
قبل أن تفتح الرابط، تلتفت، يُمنة ويُسرة، مخافة أن يتطاول إليك أحدهم بعنقه، ممن يحيطون بك في مقهى، أو باحة استراحة، أو قاعة انتظار. تحرص على أن تفتحها وحدك، وتراها وحدك. أنت الذي التهمتك الدودة، ولم تترك منك قيْد أُنمُلة. الجميع يسعد بلحظة الانزواء بالتلفون، بعيدا عن البصّاصين المتلصصين. مع قليل من الحيطة، باستطاعتك تَوقي تداعيات المشهد غير المطلوبة: مشهد البياض الذي يفيض من جميع جنبات المقهى على الطاولات والكراسي، ثم يندلق على الأرضية المغسولة، أمام رواد المقهى. القاعدة العامة المرعية من قِبَل الجميع: كل واحد وشاشته، وكل واحد ودوداته البيضاوات، باستثناء الفائض الذي قد يجود به الواحد على من يرضى ويُحب. تماما، كما أُكرمتُ به، اللحظة، من أحدهم. ومع ذلك، يظل الوضع مُتحكما فيه إلى حد ما. هل الجمال كائن في الأبيض دائما؟ ألا يبقي بعض منه للأسود، للأسمراني؟
ولكن، أن ينفجر ذلك “الرقيق الأبيض”، أو بالأحرى الدود الأبيض السمين، على صفحات أصدقائك، الواقعيين منهم والافتراضيين، الأقارب والأباعد، الذكور والإناث، وبغير رغبة منك أو مُبادرة، فتلك هي الفضيحة الكبرى. بمجرد أن تبصم على الشريط الأزرق بإبهامك، تنفسح في وجهك ووجوه من تعرف كُتَل من اللحم، ومن مختلف الأعمار والجنسيات. هذا ما كان قد وقع، بالضبط، في أحد الصباحات. حين استفقتُ متأخرا، وفتحت علبتي الزرقاء، وجدت كومة من الرسائل المُستغربة والمُستنكرة. آه، ليلة أمس، بصمت بإبهامي على رابط أزرق من دون قصد. الاستغراب والاستنكار كانا في بداية طفرة الإعلاميات. لكن، مع مرور الوقت، بدأ الجميع يتفهّم بأن ليس باليد حيلة، بعد أن يُملّوا عيونهم بالألوان القزحية، المنهالة عليهم بلحومها وشحومها الغضة، من كل جانب. حتى زوجتك، أو زوجة أخيك، أو أختك، أو ابنتك، أو زميلتك في العمل…كلهن صرن يتفهمن الوضع الحالي، مُلقين باللائمة على التكنولوجيا الوقحة. الجميع يشتم التكنولوجيا، والجميع يجري إليها جري الأرنب، هاربا من السلوقيّ. هل سمعت أن رفض أحد آيفون 15، برشاقته وسرعته الجنونية، وذكائه الحادّ؟ بالنسبة إليّ، شخصيا، لأعترف بالحقيقة. إبهامي الخشن لا يستطيع التّحكُّم في الملامس الرطبة الناعمة الزلقة للشاشة. بدل أن أرسل الصورة إلى صديقي محمد، أرسلتها إلى أمي في روضة الرحمة، أو جنة الرضوان.
لكن، يحصل أن يدلف أحدهم إلى بيتك الافتراضي الأزرق عنوة، بعد أن أقمت به سنوات طويلة، وأثّتته بما يليق من صور دودية ملونة، وفيديوهات مباشرة، وتدوينات مزروعة بأقوال فلاسفة، ومسقية بمأثور حكماء، ثم يطردك منه طردا. ذلك مما لا يمكن توقعه، وتقبُّله على الإطلاق. الإنسان يموت على بْلادو، أو وْلادو، أو عْلى دودو. وإذ غدت البلاد تبتعد عني، صرتُ مأخوذا بالدفاع عن أولادي، أي دوداتي البيضاوات الجميلات. السُّذّج يفهمون الأولاد على أنهم الأبناء. هذا فهم ضيق ومحدود، لا يعير إلى ثقافة “النخوة العربية” أي اعتبار. وإذا ضممنا الجميع، بمن فيهم الأبناء والزوجة الدودة، صار الأولاد لا يتعدون إطار الدار (المنزل). غير أن الدار الزرقاء ليست ” كمثل” الدار البيضاء. إيّاكِ لا أعني، ولا تسمعي يا الشاون، يا نوارة. الدار الزرقاء على واجهتها صورتك النصفية (بالأقل)، وجميع المعلومات عن شخصك. تنتقي أجمل الصور، في أحسن الوضعيات، ثم تؤثتها بها. دارك البيضاء مفتوحة في وجوه المدعوين (على رؤوس الأصابع) من أقاربك وأصدقائك، في حين أن دارك الزرقاء مفتوحة في وجوه آلاف من الزوار، القائمين والعابرين، على مدار الساعة. الناس باتت تُصنَّف على أساس كم من بيت تمتلك: واحد في المدينة، والثاني في العروبية، والثالث على الساحل، والرابع على النّت. الأخير للدود الأبيض بالطبع.
وحتى لو كانت دارك الزرقاء افتراضية، فمن المحال أن تتقبّل أن تُحتل من أي شخص غريب. المسألة مسألة شرف قبل كل شيء. إذا تركته يمرح في بيتك الافتراضي، ويطلق رجليه بين دوداتك المسترخيات، فلا بأس أن تفسح له بيتك الطيني، أيضا، ليمرح كما شاء، مُستعملا أثاتك وأشياءك الشخصية. لا يجوز ذلك. مِن أقبح الأمور في مِلّة معظم الناس واعتقادهم، أن يكروا بيوتهم، بتاريخهم، وذكرياتهم، ولوازمهم، إلى غرباء. ولأن احتلال الملك الشخصي جريمة، حتى لو كان بيتا أثيريا أزرق، فإن الأصدقاء، الافتراضيين الخُلّص، وليس المزورين بالتأكيد، يتداعون إلى التعاطف معك، وإلى نجدتك بالتنبيه سريعا. للأسف، ما أكثر أصدقاء الرخاء في أيامنا هاته!! ولا واحد يتصور أن يُحتل بيتُه، ويساق دوده الأبيض كَرها. التعاطف، في مثل هذه المصائب، ضد القراصنة المقتحمين، واجب قانوني وشرعي. القراصنة الجدد، أحاديو العين المبصرة، صاروا يعيثون في فضاء الله الواسع الأزرق. كم هو ذكي من أطلق صفة القرصان، أول مرة، على هؤلاء المقتحمين. كان يعرف أن الفضاء أزرق، شبيها بأمواج البحر، التي كان يركبها قراصنة سلا.
بيتك الأزرق، المشرف من على تلّة جميلة، والمؤثت بأجمل الأفرشة، مفتوح في وجه الجميع، المحترمين والسّفلة. بيتك مثل المتحف العمومي، لا تستطيع أن تتحكم في هوية من يرتاده دائما. والناس، طويّاتها مثل التبن تحته ماء، لست عليهم بمسيطر. ومع ذلك، فالمشكل ليس في أن يلج هؤلاء أو لا يلجوا. فقط، المحذور له عنوان واحد: ألا تباغتك سيّدة الدار البيضاء، التي تدعوك إلى ترك الهاتف، الآن، في منتصف الليل، بالولوج إلى الدار الزرقاء. أن تنتقل من الدار البيضاء إلى الشاون بغتة!! من فضلك، نامي واطمئني. لدي عمل، أقضيه، ثم أعود. لكل بيت سيّدته. أنت في انتظار سيدة البيت الأزرق، أقصد دودة منتصف الليل، التي لك معها موعد. عاهرات آخر الليل يتسكعن بين الحيطان الخلفية الزرقاء. العاملات بالمداومة الليلية، الوحيدات الأرِقات المهووسات. دودات كثيرات، لك حظ من لقائهن أيضا. إن شئت. الأزرق يطوي المسافات البعيدة طيّ البرق.
- أهْلين.
- أهلا وسهلا.
- كيفَك، منيح؟
- الحمد لله، بخير وعلى خير.
بالخبرة المكتسبة، وسرعة البديهة، تتحول من صفحة الميسنجر إلى حائطها على الفايس. تحاول أن تجد أي معلومة عنها، تقودك إلى الاطمئنان إلى فصيلتها الدودية. صورة مثبتة على الحائط، كأنها صورة لمارلين مونرو. تنتقل إلى معطياتها الشخصية المُسجّلة، فلا تظفر منها بشيء ذي بال. تعود إلى الميسنجر مرة أخرى.
- هل يمكن أن نتحادث مباشرة؟ تفاجئك بدعوتها السّخيّة هاته.
- لا، لا يمكن الآن. قولي لي: هل أنت لبنانية أم سورية؟
- نعم، أنا سورية، مُمرضة بكندا.
- عجيب، ولكن لهجتك الشامية لا تتوافق مع اسمك العائلي ” ليلى بنقردان”؟
فجاة، ينقطع سيل الكتابة، من دون أن يُقدَّر له التحول إلى مُكالمة صوتيّة مباشرة. في وقت آخر، تستضيفك فتاة في مُقتبل الشباب.
- عمي، من فضلك، أريد شريحة هاتفية.
- بنتي، أنا لا أفهم في كيفية الإرسال، حتى لو أردت تزويدك بها فعلا.
- عمي، شريحة من فئة عشرين درهما، وأكشف لك عن صدري.
الشابة مُستعجلة كثيرا، وعلى استعداد للزيادة في العرض. وكما كتب زفزاف، يوما، هفناك من ” يُصوِّر” طرف الخبز بعرق الجبين، وهناك من يصوره بـ ” طرف” آخر. حتى قبل أن ألتقط أنفاسي، أحسست أنها سحبت صورة من “القبيطة”، وأشهرتها في وجهي. يا إلهي، ما هذا الجما… ما هذه الجرأة؟ الوقاحة؟
- عشرون درهما، وإلا فخمسون درهما، لأكشف لك عن شيء آخر.
ارتعبت من الأمر كثيرا، وفي الصباح ذهبت إلى الشرطة الإلكترونية. الواحد هو اللي خاف على سميتو، وشخصيتو، وخدمتو.
المقيمون والعابرون، المتحولون جنسيا وهوياتيا، ما أكثرهم على جادات الفضاء الأزرق يمرحون!! يحصل أن يستدرجك من تعرف، ويريد أن يوقع بك شرا. الناس مرضى، وزادهم “النت” رهَقا. بإمكانهم أن يصطنعوا لأنفسهم أكثر من صفحة، ليتعقبوا خصومهم من المعارف بالتحرش. هذا ما حدث لي مع أحدهم. كان دودة ذكرا سمينا، كاتبا ببدلة وربطة عنق (هل خُلق من الدود الذكر والأنثى؟). على كل حال، دودتنا الذكرية هاته (والله أعلم بالحقيقة) اصطنع له صفحة جديدة، بعد أن سلخ جميع المعطيات الشخصية لكاتب آخر (باستثناء اسمه الشخصي حتى يمكنه التحايل والتعمية على هويته الحقيقية)، ثم أخذ يقصف بالآربيجي بعد كل تدوينة أنشرها. هذه الدودة “المحترمة” ضخمة. ولو حدث أن صادفتها، مرة أخرى، في جوف ثمرة، لالتهمتها كما نصحني والدي قائلا: “دودو من عودو”.