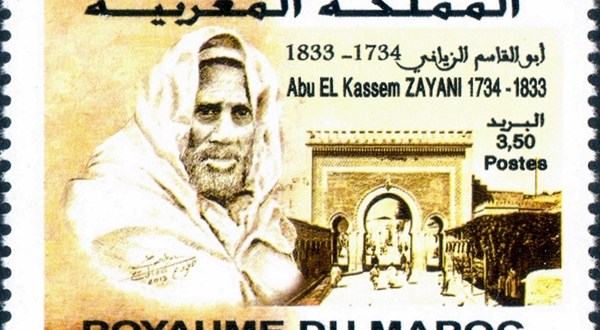قادني عدم معرفتي بالإسبانية، عند دخولي مطار بالما دي يوركا، إلى البحث عمن في وجهه سحنة عربية، لأن يترجم لي ما طلب مني موظف الجمارك الإسباني. الرجل الذي بعثته إلي “السماء”، في اللحظة الضيقة، كان عابرا لمطار الجزيرة، التي يبدو أن العرب قلما يتواجدون بها، بالمقارنة مع باقي مدن شبه الجزيرة الإيبيرية. هذا مجرد تخمين ليس غير. وقد بنيته على ملاحظتي الغياب شبه التام لمواطني بني جلدتنا، من قيس وربيعة، صنهاجة وزناتة.
كان العربي العابر رجلا لطيفا، متعاونا معي إلى أقصى الحدود. وعلى الرغم من عربيته “المغلقة” بعض الشيء، والتي كان يصر أن تشوبها دعوات لي بالصحة، ورحمة الوالدين، وهو الشاب الذي لم يتجاوز منتصف الثلاثين كما قدرت، إلا أنني نجحت في التواصل معه، والاقتراب من محتده البدوي الأصيل.
قلت له: من أي بلاد العربان ابن عمنا؟ أجابني بما لم يكن لي في حساب: أنا صحراوي. كنت أعتقد أنه ليبي، أو جزائري من الجنوب الغربي. مع نفسي، قلت وبسخرية سياسية حادة، تحت تأثير استمرار هذا النزاع الإقليمي المفتعل: وهل هناك مواطنة صحراوية؟ أن تقول صحراوي، كأن تقول: أنا بحراوي، أو غابوي، أو سماوي؟ الصحراء موجودة في أكثر من بلد من بلدان العالم. هل التسمية هاته تنبىء بشيء ما؟
في الواقع، لم أستطع أن أطرد عني مثل هذه الأسئلة، وإن جاءت في سياق حديث النفس إلى النفس. ولإزاحة كل ذلك، ابتسمت في وجهه مرحباً. إنه أخي، في الواقع، وليس ابن عمي. ونحن نتجه إلى موظف الجمارك، أخبرني بأنه يعيش في إسبانيا، ثم أضاف: الغربة صعبة يا أخي. ولكن الوضع هناك أصعب. استدركت عليه مباشرة: تقصد في تندوف؟ رد علي محركا رأسه بالإيجاب. وحتى يقطع علي الطريق إلى أي سؤال، يمكن أن أبتدره به، مستغلا توزعه بين الغربة في تندوف والغربة في إسبانيا، علق سريعا بقوله: تندوف مثل العيون. لا فرق، هناك، بينهما. كأنه أحس أنني كنت أدفعه إلى خيار ثالث، بديلا عن غربتيه في إسبانيا وتندوف، وهو العودة إلى الوطن.
بعدها، دخل في نوبة من الشكوى: الغربة، العيشة الصعبة، برودة الناس في أوروبا.. وحتى لا أهدر فرصة الحوار معه، حول قضية الصحراء، لأعرف كيف يفكر الصحراويون “الانفصاليون”، عن كثب، لأنه أول شخص “مباشر” ألتقي به من هؤلاء، استعدت المبادرة بالتعليق التالي: كلنا في الهم شرق يا عزيزي. ومع ذلك، فليست العيون مثل تندوف. العيون، ومعها مدن أخرى في الأقاليم الجنوبية، مدينة كبيرة ولا ينقصها شيء من الضروريات على الأقل. لم يحر تعقيبا على ما أبديت. ولذلك، سمح لي الموقف بأن أكون أكثر تحررا في الإعلان عن موقفي: بدل الاستمرار في مثل هذا الوضع “المسدود” (بالنسبة إلى دعاة الانفصال)، ينبغي أن يكون النضال موجها إلى قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث يعيش المواطنون متساوين، على اختلاف أقاليمهم في الوطن الواحد، وتمايز هوياتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية. أكدت له ذلك، محركا رأسي: المواطنة الحق هي البديل، وهي التي ينبغي أن تتركز عليها نضالاتنا، لا على النزعات الانفصالية التي ليس لها مستقبل في عالم اليوم.
كنا قد وصلنا إلى موظف الجمارك. وبعد الاستفسار منه عما يتوجب العمل به في حالتي، طلب مني أن أرافقه إلى أن وصلنا إلى مكان بالمطار، ثم خاطبني: اصعد إلى الطابق فوق، ستجد بوابة كبرى، عبرها يمكنك المرور. وحرصا منه، استحثني على الصعود بسرعة. وقبل أن نفترق، كانت كلماته الأخيرة: طائرتك على الثانية عشرة، بينما طائرتي على الثانية بعد الزوال. وإذا كتب لنا، سنلتقي في باحة ما قبل الإقلاع. من جهتي، شكرته بحرارة، ودعوت له بلم الشمل مع الأهل.
من خلال هذا اللقاء العابر، حيث كنا عابرين في مطار عابر، أحسست أن الناس متعبون، في ظل انسداد الأفق: ” أفق الانفصال”. ومن أسباب شقائهم، أن لا حل إلا الإقامة في تندوف، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مزرية، تنعدم فيها أدنى درجات الكرامة الإنسانية، أو العيش في المهاجر، بعيدا عن البلد، ولا أمل حتى في زيارته خلال أشهر الصيف، مثل بقية المهاجرين في العالم كله.
كان الشاب، الذي التقيت، لطيفا، ومستعدا للحوار “بالعقل”. ومن المؤكد أن بين “الانفصاليين” مثل هذا الشاب. ولعل ما ينقص في هذا الباب، هو توسيع المبادرات المدنية، القائمة على تغيير طبيعة الخطاب مع هؤلاء “الصحراويين”.