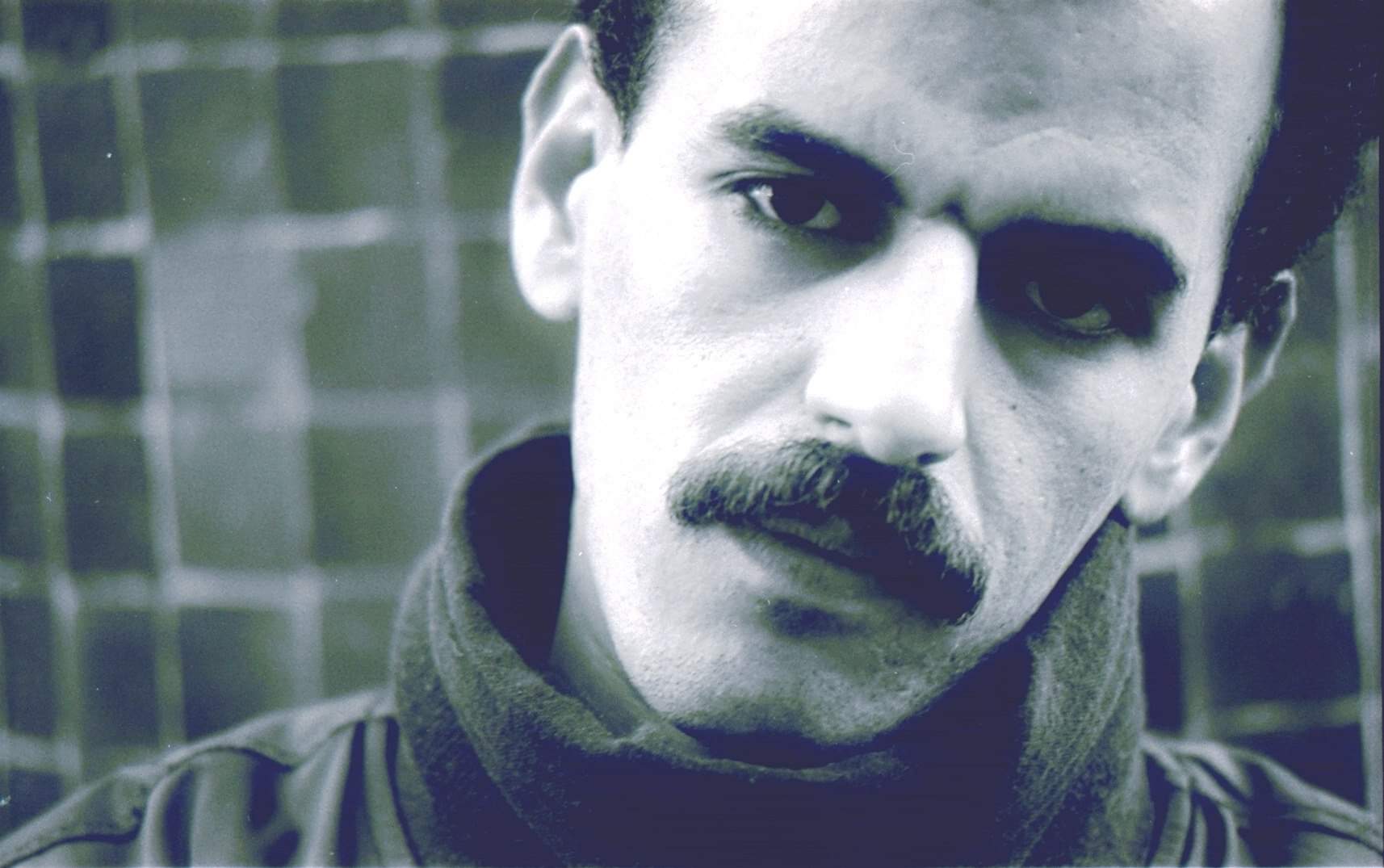
بعد أيام سيغلق معرض الكتاب المنظم بالرباط أبوابه، وسيحمل العارضون ماتبقى من حمولتهم من الكتب التي كتب لها أن تبقى في علب الكرتون تنتظر يدا رحيمة تنفض الغبار عن وجهها وتعيد لها الحياة.
سيرحل الضجيج الذي استوطن أرجاء المعرض الذي أصبح سوقا للكتاب، وفي انتظار عام آخر سيستسلم الكتاب لغفوة أشبه بحلم اليقظة كي يستطلعون الصور التي التقطوها وهم يوزعون الابتسامات ويمهرون كتبهم بإهداءات تنشر الدفئ في قلوب من جشموا أنفسهم عناء شراء الكتاب. سيأتي المياومون ليجمعوا الكراسي وينظفون الأمكنة التي عرفت نقاشات وسجالات بين الكتاب والمثقفين. سينزلون اليافطات من فوق رؤوسهم كما لو كانت عناوين لزمن ولى.
هكذا ينتهي العرس والاحتفال بالكتاب. سيلجأ المنظمون إلى حجز بعض الأيام كي ينفضوا عنهم غبار التعب من جراء ما عاشوه من ضغط يومي كي يسير الركب في خطى هادئة.
لكن أين هو الكتاب في كل هذا المحفل. أليس هو الغائب الحاضر. مثل عريس يزف في عرس والكل منشغل عنه بما يدور حوله من ضجيج وموسيقى ونقاشات حول الأفكار وحول الأثمنة.
جميل أن نخصص للكتاب معرضا عالميا، لكن هل نحن أمة تقرأ ؟ سؤال يحز في القلب حينما ترى إلى أن القراء في بلدنا شبه منعدمين. الإحتفال ليس بالضرورة المقصد النهائي. ولكن الهدف هو أن تتوج هذا الإحتفال بممثلين حقيقيين ليس بكومبارس. ماذا أعددنا كمشروع حقيقي لتصبح القراءة ممارسة يومية. أتذكر وهذا مؤسف جدا، حينما زاغ القطار وانقلب بالناس ومات من مات، وبقي من كتبت له حياة أخرى، وفي قلب هذه المأساة هناك من استغل هذا الوضع الكارثي لسرقة متاع الناس…بقيت بعض الأشياء التي لاقيمة لها، لكن الكتب لم تسرق، بل بقيت مثل جثث أشباح لن تحلم حتى بيد لتدفن عريها بما يليق بها من مجهود فكري وابداعي. ظلت الكتب هناك مرمية في الخلاء.
كيف يمكن لنا أن نشجع أولادنا على القراءة وبيوتنا كما لو أنها تحولت إلى مناطق ممنوعة لدخول الكتب. كيف أن مدارسنا لا تتوفر على مكتبات تفتح شهية الأطفال على القراءة. كيف لا نقيم محترفات للقراءة والكتابة في المؤسسات التعليمية كي ننفخ في روح هؤلاء الأطفال الرغبة في ركوب هاته المغامرة التي يسمونها الإبداع. جعلنا الطالب يقرأ فقط الكتب التي سيمتحن فيها، بحيث جعلنا القراءة ممارسة إكراهية وخالية من اللذة.
لابد من سياسة ثقافية شاملة تجعل الكتاب في قلب هذه المعركة الكبرى ألا وهي القراءة. فحينما نحبب الكتاب للقراء لا بد من مؤازرة هذا العمل عبر جعل الكتاب متوفرا عبر مكتبات في الأحياء، بل في دور الشباب والمركبات الثقافية وحتى بالمقاهي التي تحولت إلى أمينة لقتل الوقت والنظر في الفراغ. وأن نشع شراء الكتب عبر دعم الكتاب وخفض ثمنه ليكون في متناول الجميع.
من يتذكر شجاعة الكاتب الأنيق محمد بوزفور سنة 2004 والذي رفض جائزة الكتاب، لأنه لم يكن من المداهنين الذين يقبلون هذه السكيزوفرينيا المتفشية في الأذهان. كيف يقبل جائزة الكتاب والأمية في أعلى مستواياتها ولا وجود لقراء والكاتب الذي يغامر بطبع ألف نسخة هو أشبه بالمجنون.
الآن لدينا كتاب كثر والآن هناك العديد ممن يطبعون كتبا سواء كانوا كتابا أو كتبة، ودور النشر تلعب الآن دورها في الإعلاء من شأن الكتب لكنها تظل قليلة أمام حجم العمل الذي وإن كان بالإمكان بذل الكثير منه. هناك الآن مجموعات من المتحمسين والذين يحملون هم القراءة ويقومون بمبادرات أشبه بالنضال من أجل القراءة والتحسيس بها. لكن الوضع الحالي للقراءة بالمغرب محزن.
سيأتي العام القادم وينظم معرض الكتاب، وستحتفل زمرة من محبي الكتابة والقراءة، وستضخ دماء جديدة في عروق صناعة وتجارة الكتاب. لكن سيظل هناك وجه غائب إن لم نتدارك الأمر، إنه القارئ.
وسنقول للمعرض القادم كما قال المتنبي ” عيد بأي حال عدت ياعيد….”




