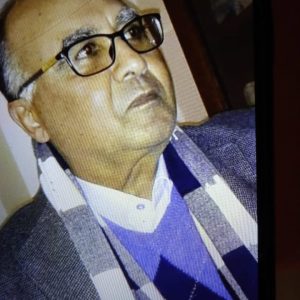
بقلم: محمد طواع*
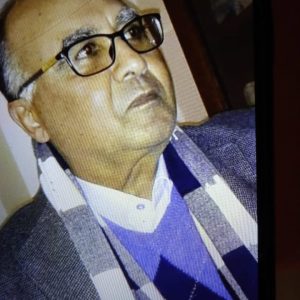
عطفا على ما ورد في مقال قيم، للكاتبة زكية لعروسي، نريد استئناف التفكير في موضوع سؤال المثقف والثقافة، في هذا الزمن الذي اكتسحته التقنية و “موظفوها”، بتعبير المفكر مارتن هيدجر. فأقول: لابد من مقدمة قبل التسآل. لقد عرف إسم المثقف، منذ ميلاده، تحولات كثيرة من حيث المعنى، والمهمة المرتبطة به أو بوضعه الاعتباري في المجتمع.
لغة، المثقف، مثله مثل الثقافة، مشتقان من مادة (ت-ق-ف)، وتعني في المجمل، الحذق والفهم والتقويم. إلى أن تحددت مهمته في إنتاج الأفكار ومساءلة الأفكار.
وقد ظهر أول بيان لنخبة المثقفين في فرنسا سنة 1898 ، موقعا من طرف كبار مثقفي نهاية القرن التاسع عشر، وعلى رأسهم إميل زولا. كان هذا تضامنا مع ما عرف بقضية “ألفريد تريفوس”. وكان ذلك إعلانا عن ميلاد” المثقف” بالمعنى الحدي للإسم. بحيث تحددت مهمته في “العمل” في المجال الفكري أو الأدبي أو الفني أو مجال التاريخ والفني أو قل أن مهمته هو الإنتاج الثقافي العالم.
لقد حدد ج .ب. سارتر مهمة هذا الكائن في المجتمع، بوصفه الإنسان الذي يدرك التعارض القائم بين ما هو علمي وما هو أيديولوجي في شأن الحقيقة. ومنحه الإيطالي جرامشي مهمة أكبر، وهي العمل على تغيير المجتمع. ومن هنا كان ميلاد إسمي المثقف العضوي وعلاقته بالطليعة، والمثقف التقدمي. ليبرز بعد ذلك مفهوم “الأنتلجنستيا”، أي تلك الفئة من المجتمع، والتي مهمتها، النقد والدفاع عن الحقيقة والحق في الاختلاف، والمساهمة في تشكيل الثقافة الجديدة في المجتمع.
والسؤال الآن: ماذا تبقى من هذا المفهوم، للمثقف الذي تبلور منذ القرن التاسع عشر وتطور إلى غاية ستينيات القرن الماضي، في هذا العصر الذي اكتسحته التقنية الآن؟ بالجملة أقول لقد حدث “إفقار” لماهية المثقف وقيمة الثقافة، مع هيمنة التأويل التقني لكل شيء، بما في ذلك مفهوم الحقيقة: لقد أمسى كل شيء يقوم بسعر، كل “شيء”، كان كتابا أو لوحة فنية، فهو مجرد “سلعة” قابلة “للعرض”، في سوق التجارة.
أمام هذا الوضع التقني، لا يسعني إلا أن أصطف جهة الشاعر هولدرلين وأقول: “علينا أن نسائل كرونوس، كيف نفسر لماذا تمشي الأرض نحو حتفها” ، في هذا “الآن” الذي نكابد معضلات زمانه؟أو قل، إنه بعد “زيوس”، من يعيد الحياة إلى “أدونيس”، لتنبثق زهور شقائق النعمان من جديد، على الرغم من “قبة الشمس الحارقة”؟ أقول: ومع ذلك، حيثما هناك ضيق، هناك وميض من الأمل، لكي تحافظ الأشياء الجليلة، على نسبة من القيمة والمعنى. لأن مادام هناك “إنسان شاعر”، يكابد وعورة مسالك المتاه، يمشي “مؤذنا”، مخاطبا البشر: أولا تذكرون نور الجمال المقدس أم أصابكم النسيان، من فرط الضجيج؟ علينا ترك” الآذان” للآذان إلى الأبد. ذلك أن من يصم الآذان، لا يسمع سوى نفسه، ولا يتذكر الجمال، إلا بعد أن تجف الينابيع.
صحيح أن القضية هي قضيتنا، ليس مع إرادات شخصية تتوهم الامتلاء، بقدر ما أن قضيتنا هي مع العصر الجارف برمته. وهو العصر الذي عمل، وبفواعل متعددة، على رأسها الإعلام، على خلق ” المسوخ” عوض الجمال. وإلا ماذا ننتظر من موظفي هذا العصر، “موظفي التقنية”، وقد هيمنوا على تدبير كل شيء، في مختلف مجالات السياسات العمومية، وعلى رأسها مجال الثقافة حتى؟
وماذا ننتظر من إعلام لا ينفتح سوى على عين الوجوه، التي تتكلم في كل “شأن”، من الشأن العام، من الاقتصاد إلى الحروب و الكوارث ومختلف التظاهرات… إعلام توفق في صنع “كائنات بهلوانية”، تجتهد في السباق نحو “أخذ” ميكرفون، للكلام في كل شيء. ولكل من يريد الانخراط في المحفل، عليه أن يبدي القدرة الفائقة على تغيير ملامحه، ليظهر بوجه ذي هوية بدون ملامح.
سؤال الثقافة الآن، وخاصة ثقافة الكتابة باليد، كتابة الذاكرة الورقية، كما طرحته الكاتبة لعروسي، سؤال عويص بالنظر للعصر الذي نقيم فيه، العصر الذي اكتسحت صوره مختلف مناحي الحياة.
أعيد وأقول لقد تحولت الثقافة إلى “شيء” يقوم بمنطق العرض والطلب. والحجة في ذلك الجو الذي أصبح يسود معارض الكتاب كل سنة، بما في ذلك المعرض الدولي للكتاب. ذلك أنه على الرغم من برمجة “ثقافية” مواكبة ليومياته، بالجلسات والمحاضرات التي تكون، نظرا لمنطق البرمجة وعدد المتدخلين، مضغوط عليها من حيث زمن الجلسات. وهو ما يخيل إليك في النهاية أن الأمور هي فقط “للشكل” ليس إلا. والطامة الكبرى هي أن ليس هناك ما يمكن تسميته “تدويرا” للوجوه. عين للاعبين، وكأن من برمج للمعرض لا يهمه الكتاب الجدد، وكأن الأرض لا ينبثق عنها الجديد، أو غير ولادة للكتاب والمثقفين الجدد أو ربما الأمر ناتج عن تمثل يفيد أن الحذق، لا ينضج إلا مع الهرم.
الحجة الثانية تتمثل في واقع النشر عندنا: كيف يمكن أن نفهم، كون وزارة الثقافة، تتخلى عن مهمة أساسية وهي نشر الكتاب ورعاية الثقافة برعاية المثقف؟ ما معنى أن يجد الكاتب معضلة حقيقية، وهي أن عليه هو أن يقوم بالرقن والتصحيح لعمله بنفسه، ليتيه بين دور النشر، لكي يحصل على “فرصة” للنشر. وهذا مع غياب كلي “لحقوق” متعاقد بقوة القانون. وذلك صونا، لوضع اعتباري يليق بمن يريد أن يعيش “بمهنة” الكتابة، وحماية له، أو يريد أن يعيش باعتباره كاتبا ؟ و ما معنى أنه لما تريد اقتناء نسخة من عملك، تتم معاملتك كباقي “الزبائن”، مع خصم في السعر، هزيل؟؟
وضع مثل ما يعيشه الكاتب عندنا، هو ما دفع عددا منهم إلى أن يتحولوا إلى كتاب/ناشرين وموزعين، حفاظا على ما الوجه.
أمر ٱخر أريد أن أشير إليه، بناء على ما هو سائد، في برامج التلفزيون عندنا، هل فعلا لنا برامج ثقافية، هادفة إلى تثمين هذا البعد المؤسس للوجود البشري الرمزي للشعوب، وهو الثقافة؟ أو أنه بالنظر لنوع الوثائقيات التي تطل علينا، وهو شيء محمود، يمكن أن نتساءل عن مفهوم الثقافة عندنا؟ وما التصور الذي كان من راء تلك الوثائقيات، إن لم يكن هاجسه هو خدمة مجال آخر ليس، أساسا، هو الثقافة؟ جميل أن تكون الثقافة في خدمة السياحة والدبلوماسية، لكن بالتفكير الجدي في وضع اعتباري حقيقي للمثقف.
أكتفي بهذه الإشارات واقول: ومع ذلك الكاتب، ومع غياب التحفيز، لا يتنازل عن مهمته: وهي الكتابة ليقول كلمته بصدد الوجود البشري، قبل أن يرحل، مؤمنا بأن ما يدوم، في الزمان أكثر من دوام النحاس، هو ما يتم “تشييده” بشكل جمالي/شعري، ليترك شهادة على المرور. وهو مقتنع بحقيقة أنه من الوهم أن تعيش بوصفك من “الالنتلجنستيا”، في هذا العصر الضنين. لذلك نجد الكتاب هم عينهم من عاش بوصفه موظفا أساسا، لتدبير مطالب الحياة.
في الختم أقول: ومع ذلك، ستبقى مهمة المثقف بالفعل، هي الكتابة والإبداع، ووضع النقط على الحروف، من أجل مقاومة مختلف أشكال البهامة والتفاهة، بوصفهما الخطر الذي يهدد الفكر والإبداع والفن، وأن يدافع، “بعقل أنواري”، عن الحق في النقاش وإبداء الرأي، وأن يعمل بمبدأ:” قد أختلف معك، هذا هو الأصل في حقيقة الأمر، لكن سأدافع عن حقك في الكلام”. خاصة وأن هذا الزمن قد خلق ظاهرة جديدة وهي ظاهرة، ما يصطلح عليه “المؤثر صانع محتوى”. و هي أكبر كذبة، أريد بها وضع المثقف في الزاوية الرمادية. هذا هو الرهان والتحدي.
* كاتب مختص في البحث الفلسفي المعاصر و في وعلوم التربية
