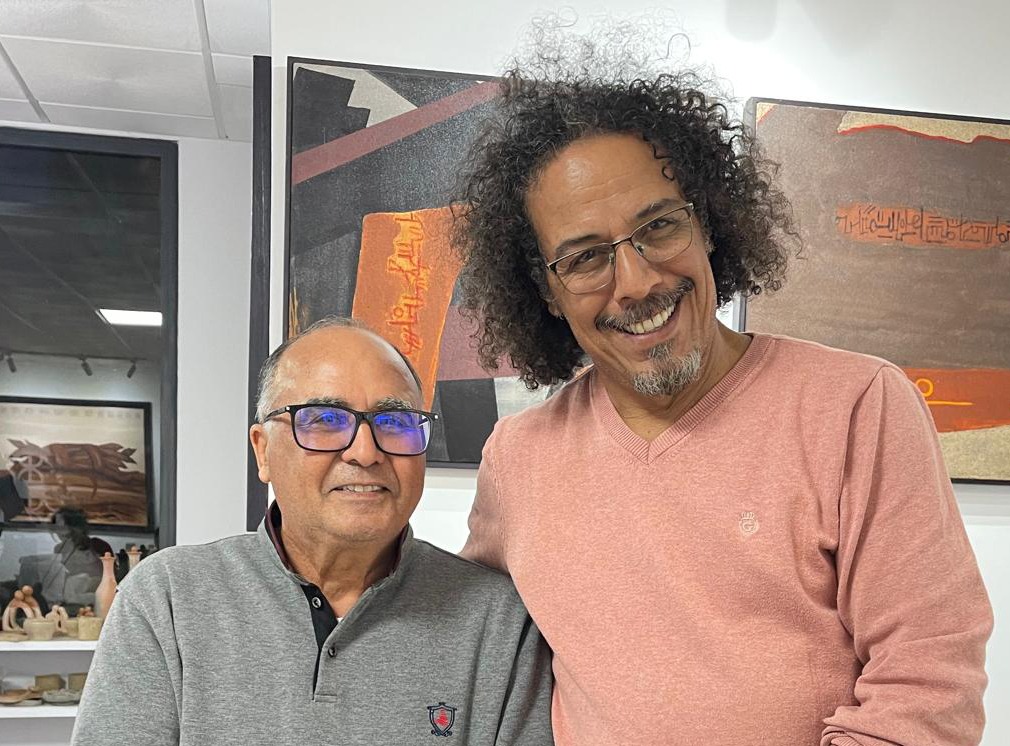
بقلم: محمد طواع*

بعد معرض “الأرض محمولي الحميمي” الذي تم تنظيمه بمعبده/مرسمه، بين دجنر2023 و يناير 2024، تطل علينا عيون أعمال الفنان التشكيلي المصطفى غزلاني في المعرض الذي تم تنظيمه، هذا الشهر قبل الأخير من سنة 2024 في نزل سفانكس. Le sphinx بمدينة المحمدية.
وهو حدث لاعتبارين، الأول كون المعرض نظم في اقدم نزل بمدينة الزهور “سابقا”، فضاء تاريخي، هادئ وجميل، نزل عجيب بمقامه تحث هذا الاسم الأسطوري –سفانكس، ذلك الكائن حارس أبو الهول. وهو النزل الذي كان يقيم فيه المغني الشهير جاك بريل لما يريد استراحة في المغرب، وقامات أخرى مثل سيمون ديبوفوار، إديت بياف، ويسطون شيرشيل … هذا الفضاء الأسطوري سيفتح دراعيه لزوار إضافيين من عشاق الفن التشكيلي وذلك حتى يوم 23 من شهر دجنبر.
أما الاعتبار الثاني لهذا الحدث، فيعود للوضع الثقافي في هذه المدينة التي لا نتابع فيها، بسكون طرف، سوى زحف الاسمنت وانسداد آفاق الثقافي. هذا الوضع تشهد عليه الحالة التي آلت إليه تلك المؤسسات التي أنشئت لهذا الغرض، وما يثبت ذلك،الحالة المؤلمة التي عليها دار الثقافة والمسرح، أما دور السينما فقد اختفت بالمرة. وعليه، يبقى هذا المعرض إضاءة في ظل هذا الزمن الضنين – البخيل بالشيء النفيس، الذي تمر منه هذه المدينة.
يعتبر هذا المعرض امتدادا، واستئنافا لعين الانهمام الذي يسكن دم هذا الفنان، إنه الانهمام بروح عين الشيء الذي يحيل على اسم بروميثوس والمقدس في بعده الشعري. ذلك أن أعماله تعين أسماء التراب والحديد والماء والأثر والطبيعة، وهي الأسماء التي تشير إليها الملصقات المصاحبة للأعمال في المعرض.
اتخذت جل الأعمال الخشب والقماش كسند لما تروم إظهاره، كما أن التقنية التي تم اعتمادها فهي تقنية مختلطة.
وأنا أقف على تلك الأعمال، استوقفتني مجموعة من اللوحات والمنحوتات. من بينها تلك اللوحة التي اعتمدت الشراع كرمز للإظهار، ونحن نعرف علاقة الأشرعة بالرياح والمغامرة والسفر. وكأن الفنان بهذا الاختيار يضعنا وجها لوجه أمام ما تنادي به الأرض اليوم وكأنها تأخذ نفسها في رحلتها الأخيرة.
لوحة أخرى اتخذت رمزية المرج لما يكون مرحا، وأخرى تُكلمنا عن حكاية الماء الأبدية، تلك التي خطت أثرها محفورا فالقا لتضاريس الأرض، أو تلك التي تحرر حكاية ألواح الطين والصخور والحلم. وهي الحكاية التي تذكرنا طروسها المحفورة على الصخر، بإشهاد الكائن الوحيد الذي يدرك فناءه، ما يجعل منه كائنا يعيش على فكرة الموت. لذا، ولكي يقاوم ضد الموت، كانت يده تخط وترسم وتحفروتشم لتترك الأثر إشهادا على العبور. ومن بين طروس هذه التجربة الوجودية، ما هو مصان مع ما نعرفه الآن في تاريخ الفن تحت اسم الفن الصخري.
تتكلم الملصقات المصاحبة لتلك الأعمال لغة ما أسماه الإغريق بلفظ الفيزيس. ذلك أن عباقرة الإغريق، مؤسسي الفلسفة والعلوم والفنون، اتخذوا هذا الاسم لتقريب ماهية منحدر كل فنن،ذلك الذي يتجلى مع وبكل ما يفنن. ومنه لفظ ” الفنين” في لغة الفلاح لما يتكلم عن تتفتق البراعم. وهو عين اللفظ الذي تمت ترجمته عندنا في المأثور الفلسفي، بالطبيعة.
أما بالنسبة للمنحوتات الحديدية، فهي كذلك تنفتح على الأبصار من خلال كلمات العنونة: “المنتظرة”، “لَمْقدمة”، “الحامل”، “الغاضبة”. وكما نلاحظ، هي أسماء تحيل على الأنثى؛ الكائن المسؤول عن أصل العالم.
لغة المعرض في مجملها تتكلم حكاية الترا ب والحديد، وهما شيآن – مادتان لا يمكن أن تتحرر “شيئية” ماهيتهما إلا بعنصري النار والماء. تتحرر ماهية كيمياء شيئية التراب بالمرور من الماء إلى النار ليتحول الخزف إلى سيراميك. أما الحديد فطريق تجلي ماهية شئيته، فتتخذ مسارا آخر من النار إلى الماء. وفي كلا المسارين يتم إظهار البعد الشعري من حقيقة الوجود.
يسمح هذا التأمل بطرح سؤالين: من الفنان؟ وماذا يمكن أن نتعلم من الفن؟
أولا، كلمة الفن والفنان تحيلان على ماهية الفيزيس أو الطبيعة، وهي القوة التي تفجر فعل الفنن بما هو انبثاق وتحرير لما يطل علينا من عالم اللا مرئي الملتبس، إلى المرئي. بمعنى أن “يد” الفنان، وهي تستجيب للنداء، تخوض صراعها الأبدي من أجل فسح الطريق، تشق تلاما، من أجل حضور الغياب، ذاك الذي يظهر جمالا مع العمل الفني، أو متحررا من السديم.
يجد الناظر نفسه، وهو في حيرة من أمره مستفهما: من ينظر إلى الآخر، هل عين الزائر أم عين العمل الفني؟
نبني هذا التساؤل على افتراض أن العمل الفني، مثل أي عمل إبداعي، له عين تناديك لكي تتوقف، لفترة زمنية ما، مستجيبا لضياء اللون والشكل. ذلك أننا نفترض أن الأعمال الفنية التشكيلية هي إضاءات أو إشراقات. من هنا يتجلى سحر الفرشاة باعتبارها يدا ثانية تمتد عن الجسد، وهو يصارع الألوان والتخطيطات، من أجل إظهار وميض الحقيقة باعتبارها حقيقة ظهور الغياب.
اليد والحالة هاته ليست مجرد عضو بين باقي أعضاء الجسد، صحيح أنها تقدم التحية وتقبض وتمنح وتشير وتلوح وتعين و ترقن… لكن هي أكثر من كونها كذلك، لما يتعلق الأمر بالإبداع. في هذا المجال، تنبري ك “قوة” خلاقة محررة ومظهرة. وهو ما نبني عليه القول الذي يفيد أن الفنان كائن إظهاري، كائن بإمكانه تحرير الحقيقة بيدين، يده الجسدية والأخرى الممتدة عن جسده؛ الفرشاة الممتدة عن تلك اليد، لتمسي يدا ثانية تصارع ماء وكيمياء اللون، من أجل تحرير الطريق لإظهار الجميل.
على هذا الأساس ينبغي إعمال الفكر بصدد اليد والفرشاة أو القلم حتى، فيما هما يجربان متاه تحرير ما يطل علينا على السند، بوصفه امتدادا لمنحدر الشعرية في معناه القوي-الأنطولوجي.
بهذا المعرض الثاني يكون الفنان غزلاني قد عبر عن نفس طويل في طريق تحرير الجمال والجميل، أو كأنه يقول: إنه على الرغم مما أُنجز إن قوتي الروحية تأسرني من أجل أن أتابع السير لأشق الدروب لمنحدر الشعرية اللا مرئي، لكي يأتي صوبي.
بهذا ما يفيد أنه لكي تحمل اسم فنان، معناه أن منحدر الشعرية أشار إليك، أو نادى عليك لكي تصيخ السمع وتستجيب للنداء عبر إبداع عمل فني-فكري-جمالي.
وهو يشتغل على “شيئية” المادة، مطاوعا إياها، فيما هو منهمم بالعناصر الأولى لتَشكُّل الكون، يكون غزلاني في حضرة الاستماع إلى ما يرسل على الإنسان المنفتح، بوصفه وميضا أو نداء من ثنايا لسان الأرض، اللسان المتعدد والمتنوع، الذي يتكلم امبراطورية سيميائية مطمورة، تنتظر التحرير أو الإظهار.
* ذ. باحث وكاتب في مجال الفلسفة المعاصرة






