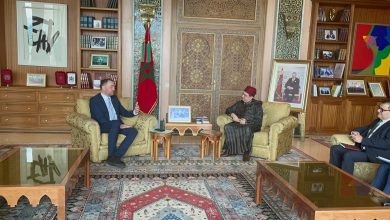في جلسة مع زميل لي والذي أصبح لاحقا أحد أصدقائي المقربين، كنا نتحدث عن الأدب وعن الرواية العربية بالتحديد، فبادرته بالسؤال عن انطباعه حول رواية “موسم الهجرة إلى الشمال”- والتي يصنفها النقاد كأحد أروع النصوص الروائية العربية في القرن العشرين – من حيث أسلوبها الأخّاذ وتناولها المتميز للعلاقة بين الشرق والغرب ولأصالة طرحها لهذه العلاقة الملتبسة والمركبة بينهما، التي هي مزيج من الانجذاب والجفاء والنفور، فقال لي مبتسما:” لقد قرأت فصولها الأولى، وحين شرع الراوي يتحدث عن مغامرات مصطفى سعيد وفتوحاته الجنسية، توقفت عن قراءتها وألقيتها جانبا.” فخاطبت نفسي:”لقد نال هذا الرجل الماثل أمامي حظه من التعليم ومازال يتحدث عن الأعمال الأدبية وفق منظور أخلاقي، بدل أن يصدر حكمه عليها على أساس جمالي وفني.”
لماذا يشعر بعض القراء ببعض الحرج والضيق، بل بالسخط والغضب أحيانا، حين يطرق كاتب عربي موضوع الجنس في أحد أعماله الأدبية، فثمة طائفة منهم مثلا يرون في رواية “الخبز الحافي” لمحمد شكري مجرد سلسلة من المشاهد الجنسية الفاضحة، وأن مؤلفها كانت له نية مبيتة للإساة إلى المغرب وتمريغ سمعته في أوحال الرذيلة وتصويره على هيئة ماخور كبير السواد الأعظم من ساكنته مجرد مهووسين جنسيا، يشرعون أبواب بلدهم لكل باحث عن اللذة الحسية وإشباع غريزته والقادم من بلد أجنبي لهذه الغاية. وهذه الأحكام الجزافية والمتسرعة لاتنهض على حجة أو دليل.
حين يؤلف أديب روايته أو قصصه حول موضوع الجنس، فإنه لايرمي بالضرورة بذلك ان يفسد النشء أو أن يسيء إلى وطنه وبني جٍلدته، بل لأن هذا الموضوع يلح عليه إلحاحا ولأنه يهدف إلى إثارته من زاوية نظر معينة، لكن بعض القراء والنقاد لايرون في ذلك إلا عملا يروج للرذيلة غايته تقويض أركان المجتمع وإفساد أفراده ذكورا وإناثا ،والحال أن الأمر ليس بهذه البداهة والسطحية، التي ترى أن رواية أو عشرات الروايات أو أكثر بمقدورها أن تجعل معمار مجتمع بكل مكوناته الراسخة منذ قرون يتداعى وينهد، ثم يجترىء جُلُّهم على أن يُملوا على الأديب مايتعين عليه أن يكتب عنه أو يزهد فيه، ثم إنهم لايدركون ماهية الأدب وظائفه في مجتمع معين، إن الأدب ليس خطاب وعظ وإرشاد، ومن يلتمس ذلك في الأدب فإنه سيعود صفر اليدين في قراءته للأعمال، ومن يلتمس ذلك الخطاب فليطلبه في مظانه، في الكتب الدينية وماشابهها وليس من أدوار النهوض بأخلاق القراء ودعوتهم إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق، إن الأدب شأنه في ذلك شأن الفلسفة عصِيٌّ على التعريف، فالاطلاع على تاريخه منذ الأزمنة السحيقة هو الذي يتسنى معه حَصْر بعض أدواره في مجتمع معين في مرحلة تاريخية من مراحله.
الأدب كما الفلسفة لايقدم حلولا لمعضلات اجتماعية والأدباء لايفترض فيهم ان يكونوا مصلحين اجتماعيين ومُربين دورهم النهوض بأخلاق جمهورهم من القراء،إن من أدواره الكشف عن بعض مواطن العلل والعاهات الاجتماعية وبعض العادات والتقاليد التي يستهجنها عامة الناس واستكشاف تضاعيف النفس البشرية بأهوائها المتداخلة والمتضاربة في الآن نفسه وإماطة اللثام عن الفساد السياسي وغيره من ألوان الفساد وتقويض الأكاذيب والأراجيف، وغايته الأعظم هي طرق مواضيع لا عَدَّ لها ولاحصر في قالب فني مادته الخام هي اللغة وفق معمار خاص، و وظيفته الجمالية والفنية يتم إهمالها في أغلب الأحيان للعناية حصرا بالمواضيع التي يتناولها.
ثمة علاقة شديدة الالتباس والتعقيد بين النظرة إلى الأدب وتأثيره على جمهور القراء، فثمة من يرى أن الاطلاع على روايات تعج بالمشاهد الجنسية سيفضي بقارئها إلى الهوس الجنسي أو الانصراف إلى كل الانحرافات الجنسية يجربها ويَلِذُّ بها إلى أن يُلقي بنفسه في غياهب الرذيلة، والحال أن تأثير الأدب على قرائه محدود للغاية، و هو في أسوأ الأحوال ليس تأثيرا ميكانيكيا، وإلا فإن المدمنين على قراءة الروايات البوليسية سيُمْسون قتلة بالتسلسل،لأن معظم الروايات التي يقرأونها تعج بأحداث القتل والانتقام ،وسيكون قراء روايات الماركيز دو ساد ساديين بالضرورة في علاقاتهم الجنسية، ثمة تهويل لدور الأدب وتضخيم لمفعوله في نفوس قارئيه وعقولهم،لذا لايحْسُنُ أن نتهم الأدب بكل أوصاب المجتمع ونقائصه، وأن نزهد فيه بدعوى أنه مُفسد للعقول والأبدان. استهل الأديب الروسي العظيم تولستوي في روايته ” آنا كارنينا” Anna Karénine بحقيقة فحواها أن الأسر التي تنعم بالسعادة لا قصة لها خليق بالروائي أن يحكيها، وحدها الأسر التي تشقى في التعاسة بوسع الروائي أن يعثر في حياتها على مادته التي يصبها في قالب سردي، لأن السعادة شعور غامر لايمكن نقله بالكلمات، ثم ما الذي يمكن أن يستثير القارىء في حياة أسرة أو أشخاص سعداء، وحدها الأعطاب و الآلام والعاهات والاضطرابات النفسية وغيرها والبؤس والقهر والمعاناة بكل صورها تدفع القارىء أن يتتبع مصائر هذه الشخصيات بل يصل به الأمر أحيانا أن يتماهى معها فيأسى لأساها ويغتبط إن هي أفلحت في بلوغ مبتغاها.
الكتابة عن الجنس ليست ترفا أو وسيلة لاسثتارة الغرائز الحسية، بل هي رغبة في فهم بعض جوانبها، باعتبارها تؤدي دورا محوريا في التوازن النفسي في حياة الأفراد والمجتمعات، ثم إن الجنس غريزة بالغة التعقيد ومتعددة الأوجه والأبعاد، فمن الأدباء من ينظر إلى انحرافاتها و حالاتها المرضية كما تناولها المركيز دوساد في جل رواياته أو جورج باتاي Georges Bataille أو Masoch ومن إسميهما تم نحث كلمتي السادية والمازوخية، وهما انحرافان جنسيان اهتم فرويد و من تلاه من باحثي التحليل النفسي بتحليل منشئها وبعض مظاهرها، لكن الروائي الذي كرس حياته وجل أعماله لطرق موضوع الجنس ولتحليل مظاهر الغريزة في صلاتها بالدين و الطبيعة والانتماء الطبقي وفي شتى مظاهرها هو بلا شك الكاتب الأنجليزي دفيد هربرت لورنسDavid Herbert Lawrence الذي كان بعض النقاد يصفونه بالبذيء the obsene، والذي لم تنشر باكورة أعماله بأنجلترا “عشيق السيدة شاترلي ” L’amant de Lady Chatterlry إلا سنوات بعد وفاته، ففي رواياته “نساء عاشقات” و”قوس قزح” و” عشاق وأبناء” وأعماله الأخرى، يتصدى د.ه.لورنس للنظر من زوايا نظر مختلفة للجنس باعتباره مكونا أساسيا في حياة بني البشر،بل وسيلة من التحرر من ربقة الاستلاب الذي يكرسه النظام الرأسمالي، وباعتباره ممارسة للالتحام من جديد بالطبيعة في صورها المختلفة، وأكاد أجزم بأنه ليس ثمة من كاتب برع أيما براعة في ربط الجنس بجل أنشطة الإنسان المعاصر، وشدد على ضرورة النظر إليه باعتباره أداة للترقي النفسي والروحي للبشر، ونظر إليه من زواية نظر فلسفية، معتبرا أن من بين أسباب تعاسة الإنسان كل تلك العقابيل التي تحيط بالجنس وتجعل منه نشاطا قذرا وذلك يعود بالتأكيد إلى الطابوهات التي تحيطه بها الأخلاق والأديان وبخاصة المسيحية التي تقصر الممارسة على الإنجاب وتُجردها من دافع المتعة، بل تحسب المتعة غاية مُنكَرة، ويتقاطع خطاب ود.ه.لورنس مع ويليام رايخ Wilhelm Reich الذي تناول موضوع الجنس في أحد أشهر مؤلفاته La révolution sexuelle حيث أفاض في الحديث عن الجنس باعتباره سبيلا من سبل التحرر والانطلاق، لكن د.ه. لورنس يبقى أهم كاتب تناول موضوع الجنس وسعى إلى فهمه و وضعه في المنزلة التي هو جدير بها بين كل الوظائف الفيزيولوجية والنفسية للإنسان و قام بتحليل أداوره بعمق يندر أن نعثر له على من يضارعه في ذلك بين من سبقوه من أدباء و اللاحقين منهم.